بالسَّنَدِ المتُصِلِ إلى أفْضَلِ المُحَدِّثينَ والحسنِ وعليِّ بنِ محمَّدٍ، عن سهلِ بن زياد، عن محمَّدِ بنِ عيسى، عن عُبَيْدِ الله بنِ عبد الله الدِّهْقانِ، عن دُرُسْتَ الواسِطي، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الحَميدَِ أَقْدمِهِمْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقوبَ الكُلَيْنِيِّ ـ رضوانُ الله عليه ـ عَنْ مُحَمَّدِ، عن أبي الحسنِ موسى عليه السّلام قالَ: «دَخَلَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلم الْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ، فَقَالَ: مَا هذَا؟ فَقيلَ: عَلاَّمَةٌ، فَقَالَ: وَمَا الْعَلاَّمَةُ؟ فَقَالُوا لَهُ: أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ العَرَبِ وَوَقَائِعِهَا وَأَيّامِ الجَاهِلِيَّةِ وَالأَشْعَارِ العَرَبِيَّةِ، قَالِ: فَقَالَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلم: ذاكَ عِلْمٌ لاَ يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَلاَ يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلم: إنَّما العِلْمُ ثَلاَثَةٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، وَمَا خَلاهُنَّ فَهُو فَضْلٌ»[1].
الشرح:
ورد في بعض النسخ مكان (ما هذا)، (من هذا). واستعمل صلوات الله عليه (ما هذا) لأجل التحقير.
و (العَلاّمة) صيغة المبالغة، والتاء أيضاً للمبالغة والمعنى كثير العلم جداً.
إعلم أنه ذكر في المنطق بأن (من) للسؤال عن الشخص وكلمة (ما) للسؤال عن الحقيقة أو عن شرح الاسم ومفهومه. وعندما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الرجل علاّمة، استفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تصورهم لحقيقة العلامة، ومغزى علمه، ولهذا سأل بكلمة (ما). فإنه قد تجعل الأوصاف العنوانية ـ العلامة ـ وسيلة للسؤال عن الذات. مثل ما إذا كان الإنسان عارفاً لحقيقة الوصف ولكنه يجهل الموصوف فيسأل حينئذ بكلمة من ويقول من العلامة؟ وأما إذا كان الشخص معروفاً والوصف مجهولاً أو أن الغرض قد تعلق بمعرفة الوصف فقط فيسأل حينئذٍ بكلمة (ما) ويتوجه السؤال نحو الوصف فقط لا الموصوف مع الوصف ولا الموصوف فقط. وفي هذا الحديث الشريف لمّا قالوا إن هذا الرجل علاّمة، تعلق غرض خاتم النبيين نحو معرفة حقيقة الوصف حسب زعمهم فقال (وما العلامة؟) ولم يقل (من العلامة؟) أو (لماذا يقال له العلامة؟) أو (ما السبب في كونه علامة؟).
وما ذكرناه أوضح ممّا حققه محقق الفلاسفة وفيلسوف المحققين صدر
المتألهين ـ قدس الله نفسه ـ في شرح هذا الحديث الشريف الذي يوجب ذكره الإطالة والخروج عن المقصد.
فصل: أقسام العلوم النافعة
اعلم ـ قد تقدم سابقاً ـ بأن للإنسان ـ إجمالاً وبصورة كلية ـ نشآت ومقامات وعوالم ثلاث:
الأولى ـ نشأة الآخرة، وعالم الغيب، ومقام الروحانية والعقل.
الثانية ـ نشأة البرزخ وعالم متوسط بين العالمين، ومقام الخيال.
الثالثة ـ نشأة الدنيا ومقام المُلك وعالم الشهادة. ولكل منها كمال خاص وتربية خاصة وعمل يتناسب مع نشأته ومقامه، وأن الأنبياء عليهم السلام يتولّون بيان تلك الأعمال.
فجميع العلوم النافعة تنقسم إلى هذه العلوم الثلاثة:
علم راجع إلى الكمالات العقلية والوظائف الروحية. وعلم راجع إلى الأعمال القلبية ووظائفها. وعلم راجع إلى الأعمال القالبية الخارجية، ووظائف النشأة الظاهرة للنفس.
أما العلوم التي تقوّي العالم الروحاني، والعقل المجرد وتربيتهما فهي: العلم بالذات المقدس الحق جلّ وعلا، ومعرفة أوصافه الجمالية والجلالية، والعلم بالعوالم الغيبة المجردة مثل الملائكة وأصنافهم من أعلى مراتب الجبروت الأعلى والملكوت الأعلى إلى نهاية الملكوت السفلي والملائكة الأرضية وجنود الحق سبحانه. والعلم بالأنبياء والأولياء ومقاماتهم ومدارجهم، والعلم بالكتب المنزلية، وكيفية نزول الوحي، وتنزل الملائكة والروح. والعلم بنشأة الآخرة وكيفية عودة الموجودات إلى عالم الغيب، وحقيقة عالم البرزخ والقيامة، وتفاصيل ذلك.
وملخص الكلام أن العلم الذي يرتبط بالعالم الروحاني والعقل المجرد، هو العلم بمبدأ الوجود وحقيقته ومراتبه وبسطه وقبضه وظهوره ورجوعه. ويتكفل بيان
هذا العلم بعد الأنبياء والأولياء، الفلاسفة والعظام من الحكماء وأصحاب المعرفة والعرفان.
أما العلوم التي ترتبط بتربية القلب وترويضه والأعمال القلبية فهي: العلم بالمُنجيات الخُلقُيّة والمهلكات الخُلقية، أي العلم بمحاسن الأخلاق مثل الصبر، والشكر، والحياء والتواضع، والرضا والشجاعة والسخاء والزهد والورع والتقوى وغير ذلك من محاسن الأخلاق، والعلم بكيفية تحصيلها وأسباب حصولها ومبادئها وشرائطها. والعلم بقبائح الأخلاق مثل الحسد والكبر والرياء والحقد والغش وحب الرئاسة والجاه وحب الدنيا والنفس وغير ذلك، والعلم بمبادئها التي تمنحها الوجود، والعلم بكيفية التنزه عنها. والذي يتولىّ بيان هذه الأمور أيضاً الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام ثم علماء الأخلاق وأصحاب الرياضة الروحية وذوي المعارف.
والعلوم التي تناط بها تربية الظاهر وترويضه، علم الفقه ومبادئه، وعلم آداب المعاشرة وتدبير المنزل، وسياسة المُدُن ويتكفل بشرحها الأنبياء ثم الأولياء عليهم السلام ثم علماء الظاهر من الفقهاء والمحدّثين. ولابد من معرفة كل واحد من هذه المراتب الثلاث الإنسانية المذكورة مترابطة بدرجة، تنعكس آثار كل مرتبة على المرتبة الأخرى من دون فرق في ذلك بين الأمور الكمالية، أو الأمور القبيحة المعيبة.
مثلا لو أن شخصاً قام بالوظائف العبودية والمناسك الظاهرية ـ حسب ما هو لازم ومطابق لتوجيهات الأنبياء ـ لانعكست من جرّاء أدائه لمسئولياته العبودية آثار على قلبه وروحه، حيث يحسن خلقه، وتتكامل عقائده. وهكذا فان من يواظب على تهذيب خلقه وتحسين باطنه، يترك آثاراً على النشأتين الأخرويتين البرزخ والقيامة. كما أن كمال الإيمان ومتانة العقائد يؤثران في النشأتين التاليتين. ويكون كل ذلك نتيجة شدة الارتباط بين المقامات الثلاثة، بل التعبير بالارتباط بين العوالم الثلاثة من جهة ضيق الخناق لعدم وجود كلمة أخرى تعبّر عن مدى تداخل كل منها في الآخر. إذ لابد وأن نقول إنها ـ العوالم الثلاثة ـ حقيقة واحدة، ذات مظاهر ثلاثة. وهكذا كمالات المقامات الثلاثة مرتبطة بكمالات كل واحد منها. من دون
أن يظن أحد أنه يستطيع أن يكون ذا إيمان كامل أو خلق مهذب من دون الأعمال الظاهرية، والعبادات الصورية. أو يستطيع أن يجعل إيمانه كاملا وأعماله تامةً، رغم نقصان في خُلقة وعدم تهذيبه، أو يمكن أن يتم أعماله الظاهرية ويكمّل محاسن أخلاقه من دون الإيمان القلبي. وهكذا عندما تكون الإعمال الصورية ـ الصلاة، الصوم، والحج و.. ناقصة وغير واقعة على ضوء أوامر الأنبياء، لحصل حجاب في القلب وكدرة في الروح، وهما يمنعان من نور الإيمان واليقين. وأيضا إذا كان الخلق الذميم معشعشا في القلب، لمنع من نفوذ الإيمان إليه.
فيلزم على طالب السفر إلى عالم الآخرة. والسالك على الصراط المستقيم للإنسانية أن يتمّعن في كل واحد من المراتب الثلاث، ويشدد في المراقبة عليها، ويصلحها، ويرّوضها ولا يلوي بوجهه عن كل واحد من الكمالات العلمية والعملية.
لا يحسب بأن تهذيب الخلق أو ترسيخ العقائد أو موافقة ظاهر الشريعة، يكفيه، كما اكتفى بعض أصحاب العلوم الثلاثة بكل واحد من الأمور الثلاثة. فمثلاً يقوم شيخ الإشراق في أول كتابه (حكمة الإشراق) بتقسيمات، تعود إلى: كامل في العلم والعمل، وكامل في العمل وكامل في العلم، ويستفاد من ذلك أن كلاًّ من العلم الكامل مع النقصان في العمل، أو العمل الكامل مع النقصان في العلم، يمكن أن يتحقق، واعتبر ذوي العلم الكامل، من أهل السعادة، والمرتبطين بعالم الغيب والتجرد، ورأى أن مآلهم الانخراط في سلك العليّين والروحانيين.
ويرى بعض علماء الأخلاق، وتهذيب الباطن، أن منشأ جميع الكمالات تحسين الأخلاق وتهذيب القلب وأعماله، ولا يرون دوراً للحقائق العقلية والأحكام الظاهرية، بل يعتبرونها معوّقات في سبيل السالكين.
ويزعم بعض علماء الظاهر ـ الفقهاء ـ، أن العلوم العقلية والباطنية والمعارف الإلهية من الكفر والزندقة، ويعاندون طلابها وعلمائها.
إن هؤلاء الطوائف الثلاث الذين يعتنقون هذه الآراء الثلاثة الباطلة، لمحجوبون عن المقامات الروحانية والنشآت الإنسانية، ولم يتدبروا بصورة صحيحة في علوم الأنبياء والأولياء. ولهذا كان بينهم العداء سائداً دائماً، والافتراء
متبادلاً، وكان أحدهم يرمي الآخر بالباطل، مع أنهم جميعاً على الباطل ولكنهم يختلفون في تحديد مراتب الباطل بمعنى أن أصحاب الطوائف الثلاث صادقون في تكذيب كل منهم للآخر، لا من جهة أن علمهم أو عملهم باطل بصورة مطلقة، بل من جهة أن تحديدهم للمراتب الإنسانية بهذا المستوى ـ أن أصحاب الكمال العلمي هم العليون وأن أصحاب التهذيب للباطل هم ذوو الكمالات، وأن أصحاب العلوم الظاهرية هم المقربون عند الله ـ وجعلهم العلوم والكمالات مقتصرةً على المجال الذي يرتأونه، يكون على خلاف الواقع.
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قسمّ في هذا الحديث الشريف العلوم إلى ثلاثة أقسام. ولاشك أن هذه العلوم الثلاثة، مرتبطة بهذه المراتب الثلاث كما تشهد بذلك العلوم السائدة في الكتب الإلهية وسنن الأنبياء وأحاديث المعصومين عليهم الصلاة والسّلام، حيث تكون العلوم لديهم مقسّمة إلى هذه الأقسام الثلاثة:
أحدهما: ـ العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، فإن الكتب السماوية وخاصة الكتاب الإلهي الجامع والقرآن الربوبي الكريم مشحونة، من ذلك، بل نستطيع أن نقول إن الشيء الوحيد الذي تصدّى كتاب الله لذكره أكثر من غيره، هو هذا العلم، مع الدعوة إلى المبدأ والمعاد على أساس براهين صحيحة ووضوح كامل ذكرها المحققون.
وأما القسم الثاني والثالث فلا ذكر لهما بمقدار القسم الأول.
وإن أحاديث أئمة الهدى عليهم السلام في هذا المجال ـ القسم الأول من العلوم الثلاثة ـ تفوق حدّ الإحصاء. ويتضح ذلك عند مراجعتنا للكتب المعتبرة لدى جميع العلماء رضوان الله عليهم مثل كتاب (الكافي) الشريف و(توحيد الصدوق) وغيرهما.
وهكذا وردت بالنسبة إلى تهذيب النفس وإصلاح الأخلاق وتعديلها، آيات في الكتاب الإلهي، وأحاديث مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، فوق المستوى المتصور، ولكن تلك الآيات وهذه الروايات أصبحت لدينا نحن المساكين والمبتلين بالآمال والأماني، مهجورة وغير معتبرة ولا نبالي بها. وسيأتي يوم يؤاخذنا
الله سبحانه عليها، ويحتج علينا، ويتبرأ منا ـ نعوذ بالله ـ الأئمة الأطهار عليهم السلام، لبراءتنا من أحاديثهم وعلومهم. نعوذ بالله من سوء العاقبة وشر الختام.
وإن الأحاديث العائدة إلى الفقه والمناسك الظاهرية، مشحونة بها في كل كتبنا ولا نحتاج إلى عرضها وذكرها.
إذا اتضح أن علوم الشريعة منحصرة في هذه الأقسام الثلاثة، حسب حاجات الإنسان، والمقامات الإنسانية الثلاثة. ولا يحقّ لأحد من العلماء في هذه العلوم الثلاثة أن يطعن في الآخر، ولا يجب على الإنسان إذا جهل علماً أن يكذبه ويتطاول على صاحبه. وكما أن العقل السليم يعتبر التصديق من دون تصور من الأغلاط والقبائح الأخلاقية، فكذلك التكذيب لشيء من دون تصوّر بل حاله أسوء وقبحه أعظم. فإذا سألنا الله سبحانه يوم القيامة، وقال مثلا أنتم لم تكونوا تعرفون معنى وحدة الوجود حسب مسلك الحكماء، ولم تتعلّموه من الإنسان المتخصص في ذلك العلم وصاحب ذلك الفن، ولم تحصلوا على علم الفلسفة ومقدماتها فلماذا أهنتم القائل بها وكفّرتموه من دون معرفة؟
فماذا نملك من جواب أمام ساحة قدسه حتى نجيب عليه، عدا أن نطأطئ الرأس حياءً وخجلاً؟ ولا يقبل الاعتذار بأنني هكذا زعمت في نفسي. إن لكل علم مبادئ ومقدمات ولا يتيسر فهم ذلك العلم إلا بعد استيعاب تلك المقدمات، وخاصّة مثل هذه المسألة الدقيقة التي استنزفت جهود أجيال تلو أجيال، ومع ذلك يصعب فهم أصل الحقيقة ومغزاها بصورة دقيقة.
إن الشيء الذي بحثه الحكماء والفلاسفة آلاف السنين ودقّقوا فيه، هل تريد أن تدرك بعقلك الناقص، الموضوع بواسطة دراسة كتاب واحد أو قصيدة واحدة من قصائد المثنوي؟ وقطعاً لا تستطيع أن تدرك شيئا من ذلك. «رَحِمَ الله امْرَءاً عَرَفَ قَدْرَهُ وَلَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَه»[2].
وهكذا إذا سأل الله سبحانه حكيما متفلسفاً أو عارفاً متصنّعاً، لماذا جعلت العالم الفقيه قشريا وظاهريا وطعنت فيه؟ بل ما هو المبرّر الشرعي في قدحك في سلسلة من العلوم الشرعية، التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام من قبل رب الأرباب لتكميل النفوس البشرية وفي تكذيبك إيّاها وإهانتها؟ وما هو المسوّغ الشرعي أو العقلي للتطاول على مجموعة من العلماء والفقهاء؟ فما هو جوابه أمام الحق المتعالي؟ انه لا يملك جواباً إلا أن يطأطئ حياءاً مبدياً الانفعال. وعلى أي حال نترك هذه المرحلة من البحث التي تبعث على السأم والضجر.
فصل: تفسير كل من الآية المحكمة، الفريضة العادلة، السنة القائمة بعد أن تبين أن العلوم الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي هذه الفروع الثلاثة التي ذكرناها، نقول على أي علم من العلوم الثلاثة تنطبق هذه العناوين الثلاثة؟ وهذا الموضوع وإن لم يكن مهماً، فإن المهم هنا هو فهم تلك العلوم ثم السعي في سبيل طلبها وتحصيلها، ولكن من أجل شرح الحديث الشريف، لابد من الإشارة إلى تلك العلوم الثلاثة: فنقول:
إن أعاظم علمائنا رضوان الله عليهم الذين تصدوا لشرح هذا الحديث الشريف، قد اختلفوا فيما بينهم في شرحه، ولكن ذكر تلك الأقوال والشروح يسبب إطالة الحديث. ونحن سنذكر ما يخطر ببالنا القاصر في هذا الموضوع مع ذكر شواهد لم تُبيّن بعد. ثم نأتي على ذكر نكتة مهمة قد بيّنها العارف الكامل الشاه آبادي دام ظله ـ :
اعلم أن (الآية المحكمة) هي العلوم العقلية والعقائد الحقة والمعارف الإلهية. وان (الفريضة العادلة) عبارة عن علم الأخلاق وتطهير القلوب. و(السنّة القائمة) عبارة عن العلم الظاهر وعلوم الآداب القابلية ـ الصورية ـ. وذلك أن كلمة (آية) التي تكون بمعنى العلامة، تتناسب مع العلوم العقلية الإعتقادية، لأن هذه العلوم هي علامات الذات والأسماء والمعارف الأخرى. ولم نعهد من قبل، أن استعلمت الآية أو العلامة في علوم أخرى. فمثلاً نجد في موارد كثيرة من الكتاب الإلهي، بعد استعراض البرهان على وجود الصانع المقدس أو على الأسماء والصفات لذاته المقدس أو على وجود القيامة وكيفيتها وعالم الغيب والبرزخ قوله
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً[3] أو الآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكرَّونُ[4] أو لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[5]. وهذا تعبير شائع بالنسبة إلى هذه العلوم والمعارف. في حين أن كلمة (آية) لو ذكرت اثر مسألة فقهية شرعية أو أصل من الأصول الأخلاقية لكان مستهجناً. كما هو الظاهر. فعلم أن (الآية) والعلامة من مختصات ومما يتناسب مع علوم المعارف الإلهية. كما أن التوصيف بـ (الحكمة) مما ينسجم مع هذه العلوم، لأن هذه العلوم تخضع للموازين العقلية والبراهين المحكمة. وأما بقية العلوم فلا يوجد لها غالباً دليل قاطع ومتين.
وأما الدليل على أن (الفريضة العادلة) تعود إلى علم الأخلاق هو وصف الفريضة بالعادلة، لأن الخلق الحسن كما تقرر في ذلك العلم ـ علم الأخلاق ـ هو الخروج عن حدّ الإفراط والتفريط فان كلاًّ منهما مذموم ومشين، وأما العدالة التي هي الحد المتوسط والمعتدل بينهما فمستحسن. مثلا:
إن الشجاعة التي هي من أصول وأركان الخلق الحسن والملكة الفاضلة، هي الحالة المتوسطة والمعتدلة بين الإفراط، الذي يُعبّر عنه بالتَهَوّر (وهو عدم الخوف من مورد ينبغي الخوف فيه) والتفريط الذي يعبر عنه بالجبن (وهو عبارة عن الخوف في موارد لا ينبغي الخوف فيها).
والحكمة التي تكون من الأركان أيضاً تتوسط بين رذيلة (السفه) وهو استعمال الفكر في غير مورده أو في موارد التي لا ينبغي استعماله فيها. وبين رذيلة (البُله) وهو عبارة عن تعطيل القوة الفكرية في الموارد التي ينبغي استعمالها فيها.
وهكذا العفّة فإنها تتوسط بين رذيلة الشره والخمود. والسخاء يتوسط بين الإسراف والبخل.
فالفريضة العادلة تدل على انطباقها على علم الأخلاق. كما أن كلمة (الفريضة) أيضاً تُشعر بذلك. لأن الفريضة المقابلة للسُنّة الراجعة إلى القسم الثالث، يجد العقل إلى استيعابها سبيلا، كما هو شأن علم الأخلاق، على خلاف السُنّة التي تكون تعبّداً صرفاً ويكون العقل عاجزا عن إدراكه.
ولهذا نقول إن (السنة القائمة) تعود إلى العلوم التعبدية، والآداب الشرعية التي يعبر عنها بالسنة ـ فعل المعصوم وقوله وتقريره ـ والتي تعجز العقول غالباً عن إدراكها. وينحصر طريق إثباتها وفهمها بالسنة. كما أن توصيف السنة بالقائمة يتناسب مع الواجبات الشرعية، لأن كلمة إقامة الواجبات من الصلوات والزكوات وغيرهما من التعابير الشائعة الصحيحة. في حين أن هذه الكلمة لم تستعمل في العلمين الآخرين ولم يكن التعبير فيهما بالسنة صحيحا.
هذا منتهى ما يمكن تطبيقه في هذا الحديث الشريف حسب المناسبات القائمة بين كلماته. والعلم عند الله.
فصل: علامات العلوم النافعة
الآن نفسح المجال لذكر النكتة التي وعدناكم بذكرها، وهي أن الحديث الشريف قد عبّر عن علم العقائد والمعارف بالآية وهي بمعنى العلامة، والسرّ في التعبير هذا هو أن العلوم العقلية، والحقائق الاعتقادية إذا تمّ تحصيلها لأجل نفس هذه العلوم والحقائق ولأجل تجميع المفاهيم والمصطلحات وزخرفة العبارات وتزيين تركيب الكلمات بعضها مع بعض ومن ثم نقلها إلى العقول الضعيفة، للحصول على المقامات الدنيوية، لا تكون مثل هذه العلوم من الآيات المحكمة، وإنما هي حجب غليظة وأوهام واهية، لأن الإنسان إذا لم يبتغ من وراء طلب العلم، الوصول إلى الحق، والتحقق بأسماء الله وصفاته، والتخلق بأخلاق الله، سيتحول كل واحد من إدراكاته إلى دركات، وحجب مظلمة، تسوّد قلبه وتعمي بصيرته، ويصبح من مصاديق الآية المباركة التي تقول: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى)[6].
فإن المقياس في البصر في عالم الآخرة، هو بصيرة القلب، وأن الجسم والقوى تكون ـ في الآخرة ـ تابعة للقلب واللُبّ، وأن ظلّية ذلك العالم، لهذا العالم تبدو بنحو أتمّ، وأن ظِلّ الأعمى والأصم والأبكم تجاه آيات الله تعالى، هو العمى والصمم والبكم في يوم القيامة.
لا يظن علماء المفاهيم والمصطلحات والعبارات، وحافظو الكتب في الصدور، بأنهم من أهل العلم بالله والملائكة واليوم الآخر، فلو كانت علومهم علامة وآية ـ على معرفة الله ـ فلماذا لم تتنوّر قلوبهم من الآثار النورانية؟ نعم قد أُضيفت على ظلمات قلوبهم ومفاسد أخلاقهم وأعمالهم الظلمات والفساد. والقرآن الكريم قد ذكر المقياس لمعرفة العلماء حيث يقول: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) فمن لا يخشى ولا يخاف من الحق المتعالي فلا يعدّ من العلماء.
هل في قلوبنا شيء من آثار الخشية؟ وإذا كانت فلماذا لم يبد أثر منها على ظاهرنا؟ ففي الحديث الشريف عن الكافي بسنده إلى أبي بصير قال: (سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ الله عليه السلام (أبا جعفر ـ خ ل) يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «يا طالب العلم إن للعلم فَضَائِلَ كَثِيرةٍ، فَرَأسُهُ التَّواضُعُ، وَعَيْنُهُ البَرَاءَةُ مِنَ الحَسَدِ، وأذُنُهُ الفَهْمُ، وَلِسَانُهُ الصِّدقُ، وحِفْظُهُ الفَحْصُ، وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ، وَعَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الأشْيَاءِ وَالأُمُورِ، وَيَدُهُ الرَّحْمَةُ، وَرِجْلُهُ زِيَارَةُ العُلَمَاءِ، وَهِمَّتُهُ السَّلاَمَةُ، وَحِكْمَتُهُ الوَرَعُ، وَمُسْتَقَرُّهُ النَّجَاةُ، وَقَائدُهُ العَافِيَةُ، وَمَرْكَبُهُ الوَفَاءُ، وَسِلاحُهُ لِينُ الكَلِمَةِ، وَسَيْفُهُ الرِّضَا، وَقَوْسُهُ المُدَارَاةُ، وَجَيْشُهُ مُحَاوَرَةُ العُلَمَاءِ، وَمَالُهُ الأدَبُ، وَذَخِيرَتُهُ اجْتِنَابُ الذُّنوبِ، وَزَادُهُ المَعْرُوفُ، وَمَاؤُهُ المُوادَعَةُ، وَدَليلُهُ الهُدَى، وَرَفِيقُهُ مَحَبَّةُ الأخْيَارِ» [7].
إن ما استعرضه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يكون من علامات العلماء، وآثار العلوم، فمن حصل على العلوم السائدة وكان خالياً من هذه الآيات، فليعلم بأنه لاحظ له من العلم، بل هو من أصحاب الجهل والضلال، وتوجب له في عالم الآخرة هذه المفاهيم والجهل المركب والكلمات المتبادلة بينه وبين العلماء الآخرين لدى التحقيق والبحث، الحجب الظلمانية، وتكون حسرته يوم القيامة أعظم الحسرات. فالمقياس في العلم أن يكون آية وعلامة، ولا تكون له إنّية ولا أنانية، بل تضمحل لدى حصول العلم الإنّية، وتتلاشى الأنانية ولا يغدو العلم باعثاً على النخوة والأنانية والتظاهر والترفع.
ثم عبر الإمام عليه السلام عن العلم بـ (المحكمة) لأجل أن العلم الصحيح لنورانيته وضيائه في القلب، يوجب الاطمئنان، ويدحض الريب والشك، ومن الممكن أن الإنسان طيلة حياته يخوض في البراهين ومقدماتها، ويستدل لكل واحد من المعارف الإلهية براهين عديدة وأدلة كثيرة، ويتفوق على أقرانه في مقام البحث والمنافسة، ولكن تلك العلوم لم تؤثر في قلبه شيئاً، ولم تبعث لديه الاطمئنان، بل تزيده شكاً وتحيّراً والتباساً، فجميع المفاهيم والإكثار من المصطلحات، لا تجدي نفعاً، وإنما تُشغل القلب بغير الحق سبحانه، وتثنيه عن الذات المقدس، فيغفله.
أيها العزيز إن العلاج كل العلاج فيما إذا أراد الإنسان أن يكون علمه إلهيا فعليه عندما يدرس أي علم شاء، أن يبادر إلى مجاهدة النفس، ويسعى بواسطة الرياضة الروحانية، في سبيل تخليص نيته. فإن المنقذ الأساسي، ومصدر الفيض، تخليص النية، والنية الخالصة «مَنْ أَخْلَصَ لِلّهِ أرْبَعينَ صَبَاحاً جَرَتْ يَنَابِيعُ الحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ» فهذه فوائد وآثار الإخلاص في أربعين يوم. فأنت عندما بذلت الجهد أربعين عاماً أو أكثر في سبيل تجمع المصطلحات والمفاهيم العلمية، واعتبرت نفسك علامة ومن جنود الله، ولكن لم تجد أثرا للحكمة في قلبك، ولا طعماً لها على لسانك فاعلم بأن دراستك وتعبك لم يقترنا بالإخلاص بل إنما اجتهدت للشيطان والرغبات النفسية. فعندما رأيت بأن هذه العلوم لم تثمر ولم تنجع فانصرف ولو لأجل الاختبار، نحو إخلاص النية وتصفية القلب من الرذائل والكدر، فإذا لمست أثراً حاول أن تستمر في ذلك أكثر. وإن كانت التصفية لأجل الاختبار كانت هذه النية متنافية مع الإخلاص، ولكن من المحتمل أن بصيصاً من نورها يهديك.
وعلى أي حال أيها العزيز أنت محتاج في جميع العوالم: عالم البرزخ وعالم القبر وعالم القيامة ودرجاتها إلى المعارف الإلهية الحقة، والعلوم الحقيقية والخلق الحسن والأعمال الصالحة. فاجتهد أينما كنت من هذه الدرجات والمراتب، وأكثر من إخلاصك وأزل عن قلبك أوهام النفس ووساوس الشيطان حتى تظهر لك
النتائج، وتجد سبيلا إلى الحقيقة، وينفتح لك طريق الهداية، ويكون الله سبحانه في عونك.
يعلم الله سبحانه بأننا إذا انتقلنا مع هذه العلوم التافهة الباطلة وهذه الأوهام الفاسدة والقلب الكدر والخلق الذميم إلى عالم الآخرة، كيف تكون مصائبنا ومحنتنا، وكيف يكون مصيرنا، وأن أيّ ظلم ووحشة وعذاب توفر لنا هذه العلوم وهذه الأخلاق؟
فصل: أقسام العلوم الدنيوية والأخروية
نقل محقق الفلاسفة صدر الحكماء والمتألهين قدس الله سره وأجزل أجره في (شرح أصول الكافي) عن الشيخ الغزالي كلاماً طويلاً خلاصته: أن العلوم تنقسم إلى علوم دنيوية وأخروية، وجعل علم الفقه من العلوم الدنيوية. وقسم العلوم الأخروية إلى علم المكاشفة والمعاملة واعتبر علم المعاملة، هو العلم بأحوال القلوب، وعلم المكاشفة نور يحصل في القلب بعد تطهيره من الصفات المذمومة، وبه تنكشف الحقائق، وتحصل المعرفة الحقيقية بالذات والأسماء والصفات والأفعال وأسرارها وكافة المعارف الإلهية[8].
ولما كان هذا التقسيم مرضياً لدى المحقق المذكور قال في شرح هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه: (الظاهر أن هذا التقسيم الحاصر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود إلى علوم المعاملات، لأن معظم الناس ينتفعون من هذه العلوم، وأما علوم المكاشفة، فتحصل لدى قليل من الناس وتكون أعزّ من الكبريت الأحمر، كما تدل عليه أحاديث كتاب الإيمان والكفر التي سنذكرها).
يقول الكاتب إن في كلام الشيخ الغزالي إشكال. وعلى فرض صحة كلامه وعدم توجه الإشكال عليه، يرد إشكال آخر على ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى. أما الاعتراض على كلام صدر المتألهين حسب فرض صحة كلام الغزالي، فهو أن الغزالي اعتبر علم المعاملات الذي هو العلم بأحوال القلب من المنجيات حينا مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء وغير ذلك، ومن المهلكات حيناً آخر مثل الحقد والحسد والغل والغش وغيرها، وعليه لا تكون العلوم الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علوم المعاملة إلا قسم واحد منها وهو الفريضة العادلة، وقد تقدم شرح ذلك. في حين أن صدر المتألهين جعل العلوم الثلاثة من علوم المعاملة.
وأما الملاحظة الواردة على كلام الشيخ الغزالي فتتجسد في أمرين:
أحدهما: إنه اعتبر علم الفقه من العلوم الدنيوية والفقهاء من علماء الدنيا، مع أن هذا العلم من أعز علوم الآخرة. وهذا التوجه، نشأ من حب للنفس، وحب ما يتصور أنه من أهله وهو علم الأخلاق بالمعنى المتعارف المتداول بين الناس، ولهذا طعن في كل العلوم، حتى العلوم العقلية.
ثانيهما: إنه جعل المكاشفات جزءا من العلوم وأوردها في تقسيمات العلوم في حين أن الحق يستدعي أن نقول بأن العلم هو الذي يشتمل على التدبر والتمعن والبرهان والاستدلال، بينما قد تكون المكاشفات والمشاهدات نتيجة العلوم الحقيقية، وقد تكون من جراء الأعمال القلبية. وعلى أي حال إن المشاهدات والمكاشفات، والتحقق بحقائق الأسماء والصفات، يجب أن لا تندرج في تقسيمات العلوم، لأن العلوم في واد والمكاشفات في واد آخر. والأمر سهل.
فصل: أقسام العلوم حسب ما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله (ص)
إعلم أن كثيراً من العلوم تندرج على تقدير في قسم من الأقسام الثلاثة التي ذكرها رسول الله، وعلى تقدير آخر في قسم آخر. مثلاً: إن علم الطب والتشريح والنجوم والأفلاك وما يضاهيها، إذ جعلناها آية وعلامة، وكذلك علم التاريخ وأمثاله، إذا ألقينا عليه نظرة اعتبار واتّعاظ، اندرج جميعها في (الآية المحكمة)،
لأنه يحصل بواسطتها العلم بالله أو بالمعاد، أو يتأكد العلم بالله وبالمعاد وقد يندرج تحصيلها في (الفريضة العادلة) وقد يندرج تحت (السنة القائمة).
وأما إذا كانت دراسة هذه العلوم، لأجل ذاتها أو لأجل أهداف أخرى، فلو شغلتنا عن علوم الآخرة، لأصبحت مذمومة بالعرض، لأنها صرفت الناس عن الآخرة، وإن لم تشغلنا عن علوم الآخرة فليس فيها ضرر أو نفع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلوم بصورة كليّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول ـ ما كان نافعاً للإنسان حسب أحواله في النشآت الأخرى التي يعتبر الوصول إليها غاية التكوين والكائنات. وهذا القسم هو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علماً، وقسّمه إلى الأقسام الثلاثة التي وردت في الحديث الشريف.
الثاني ـ ما يضر بالإنسان ويصرفه عن وظائفه اللازمة. ويكون هذا القسم من العلوم المذمومة التي يجب على الإنسان أن لا يقترب منها مثل علم السحر، والشعوذة وأمثالهما...
الثالث ـ ما لا يوجد فيها ضرر ولا نفع، فيهدر الإنسان وقته عليها للتسلّي والتلهّي، مثل علم الموسيقى وعلم الأنساب والحساب والهندسة والأفلاك وأمثال ذلك. ولو استطاع الإنسان أن يُدخل هذا النوع من العلم تحت واحد من العلوم الثلاثة لكان أفضل. وإن لم يتمكن من ذلك، فعدم الاشتغال يكون حسناً. لأن الإنسان العاقل عندما عرف بأنه مع هذا العمر القصير، والوقت القليل، والحوادث الكثيرة، لا يستطيع أن يكون جامعاً لكل العلوم وحائزاً على جميع الفضائل، فلابد له من التفكير والتأمل في العلوم، واختيار ما يكون له أنفع، والانصراف إليه، وتكميله.
ومن العلوم أن ما هو أنفع من كل العلوم وأهمها بالنسبة إلى حياته الأبدية الخالدة هو العلم الذي أمر به الأنبياء عليهم السلام والأولياء، وحثوا الناس على تعلّمه، وهو هذه العلوم الثلاثة التي ذكرناها. والحمد لله تعالى.
ـــــــــــــــ
[1] أصول الكافي، المجلد الأول، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضلة، ح 1.
[2] غرر الحكم، باب الراء.
[3] سورة النحل، آية: 11.
[4] سورة يونس، آية: 24.
[5] سورة الرعد، آية: 4.
[6] سورة طه، آية: 124.
[7] أصول الكافي، المجلد الأول، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح 2.
[8] إحياء العلوم للغزالي، المجلد الأول، ص 19 طباعة دار المعرفة بيروت.














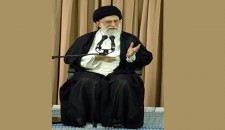



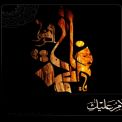
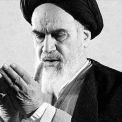



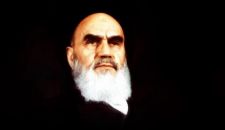
تعليقات الزوار