قراءة في المنهج المعرفي عند الإمام الخميني (قدس سره)
2007-08-20
بقلم: د.علي الحاج حسن
لا يمكن الإحاطة بشخصية الإمام الخميني (قدس سره) من دون الاعتراف بأنها شخصية ذات أبعاد متعددة تقتضي المعرفة الصحيحة بها الاطلاع على جميع هذه الأبعاد، ومعرفة خفايا المبادئ والقيم التي تحملها. الكل يعرف ان الإمام رحمه الله كان فقيهاً وأصولياً ومفسراً وفيلسوفاً وعارفاً، استطاع بمنهجيته وثقافته أن يؤسس لأهم عقيدة سياسية ـ دينية تجلّت معالمها الخارجية في الجمهورية الاسلامية كنظام. وهنا وللاطلاع على واحد من جوانب هذه الشخصية العظيمة والتعرف الى بعض خفاياها، نشير باختصار الى المنهجية المعرفية عند الإمام، التي كانت سبباً يوصلنا الى معرفة المباني الأولى والأساسية التي اعتمدها في معرفته اليقينية.
لقد اعتاد أصحاب العلوم العقلية على اعتبار الاسلوب الاستدلالي البرهاني بجميع قضاياه اليقينية والبديهية هو المستوى الأعلى والأهم في دراسة وتحليل وفهم الظواهر، وبالتالي فإن حجية النتائج التي كانوا يتوصلون اليها تتمتع بدرجة عالية من القطعية والصدق، وبالتالي فإن المعرفة التي نصل اليها والتي تستقي موادها الأولى من الحس او الخيال أو الوهم، وإن كانت صادقة بشكل جزئي ومحدود، إلا أنه يبقى هناك مجال واسع لرد ونقد هذه المعرفة، حيث لا يحصل اليقين الكافي بالنتائج. ومن هنا فإن أصحاب المنحى العقلي يعتبرون المعرفة اليقينية لا تحصل إلا من خلال أسلوب الاستدلال العقلي والبرهاني ومواده التي يجب أن تكون من البديهيات واليقينيات.. ولقد حظي هذا المنحى باهتمام كبير من قبل المسلمين، بالأخص أتباع المشائين وغيرهم ممن تأثروا بأفكار أرسطو. لكن هذا المنهج والأسلوب كان محل تحليل وتعديل من قبل العديد من أتباع المدارس الفلسفية الاسلامية. وهنا يبرز رأي الإمام الخميني (قدس سره) كواحد من الذين عارضوا هذا المنحى أو اعتبروه لا يكفي في الأغراض المعرفية، برغم الاحترام الذي كان الإمام يظهره لبعض هؤلاء الفلاسفة، سواء من اليونانيين أو المسلمين.
فالإمام (قدس سره) يعتبر أرسطو من كبار فلاسفة العالم، حتى ان القوانين المنطقية وقواعد علم الميزان التي هي أساس كل العلوم، مدينة لجهود هذا الرجل القيمة. وقد أثنى الإمام على أفلاطون قائلاً: "له في باب الإلهيات آراء متينة ومحكمة".. وتطرق الى الخدمات التي قام بها الفلاسفة والمفكرون المسلمون، فاعتبر أنهم تمكنوا من تحويل الفلسفة اليونانية الجافة الى عرفان عيني وشهود واقعي..
ومن دون الاستغراق في التفاصيل نجد ان نقطة التحول التي ظهرت عند الإمام (قدس سره) تبدأ من هنا، حيث كان البرهان والاستدلال هو الأساس في الوصول الى المعرفة اليقينية. لكن الإمام اعتبر ان الاستدلال والبرهان العقلي هو مرحلة من هذه المراحل، لكنه ليس المرحلة الأكمل. والمفارقة التي يتوقف عندها الإمام هي ان الفلسفة الاستدلالية على الرغم من أهميتها، لكنها لا تثبت إلا باستدلال لا بحصول المعرفة.. وبعبارة أخرى فإن أهمية النهج الاستدلالي تنحصر في دائرة إثبات الواقع، وليس في إدراك الحقائق وشهودها.
اعتبر الإمام (قدس سره) ان المرحلة الأرفع والأعلى على مستوى الحصول على النتائج اليقينية والمعرفية هي مرحلة الكشف والشهود، أما الوصول الى هذه المرحلة فلا يحصل إلا بعد قطع المراحل الأولى، ومن بينها البرهان والاستدلال. وهذا يعني ان البرهان والاستدلال أمر ضروري لمعرفة الحقائق وتحليل الظواهر، لكنه ليس الأداة والوسيلة التي توصل الى المعرفة اليقينية التي لا يعتريها الشك، وكل ما حصل من الطريق الشهودي فقد حصل له البرهان والاستدلال.
وقد تحدث الإمام (قدس سره) عن هذا المنهج والأسلوب مطلقاً عليه الفلسفة العليا والحكمة الإلهية، معتبراً ان هذه الحكمة والفلسفة تختلف عن الفلسفة المتعارف عليها، وهذا ما تدل عليه سيرة الأولياء عليهم السلام في وصولهم الى مشاهدة حقائق المعارف.. وهذا لا يتم إلا من خلال تجاوز المنازل العرفانية وعدم التوقف على اعتبار البرهان هو الأصل في ذلك.
ثم إن الإمام (قدس سره) يتوقف عند تعريف هذه المرحلة ويبين أهم الأمور التي تشكل الأساس البنائي لها فيقول: "إنها حالة وكيفية نفسانية تحصل من العلم البرهاني التام بمقام توحيد الله الفعلي والإيمان بهذا المقام، أي إنه بعد أن استنار من طريق العقل بالبرهان القوي الحكمي والشواهد النقلية المستفادة من النصوص القرآنية وإشارات كتاب الله وبدائعه والأحاديث الشريفة..". وعليه، فإن الحقائق البرهانية والمعارف الفلسفية مرحلة من مراحل معرفة الحقائق، والمرحلة الأعلى هي انحدار هذه المعارف من دائرة العقل الى قلب الإنسان، وهذا الذي اصطلح على تسميته بالشهود. أما المواد الأولى لهذا الشهود فتبدأ من العقل الى الشواهد النقلية والنصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، باعتبار ان هذه المواد مستقاة من مصادر فوق بشرية، تتمتع بمستوى عالٍ من اليقين والصدق، اذ ان رفع كل الاحتمالات التي تؤدي الى نقص وقصور النظرية وشموليتها يؤدي بها الى نوع أكبر من القبول.
وهنا يمكن المقارنة بين منهج الإمام ومدرسة الحكمة المتعالية الفلسفية، التي كانت محاولة للتقريب بين العقل والنص والشهود لأجل الوصول الى الحقائق المعرفية الدقيقة. وبعبارة أخرى، إن مواجهة أي ظاهرة من أكثر من جانب تؤدي الى امتلاك قدرة عالية في تحليل تلك الظاهرة، وبالتالي عدم الاقتصار على دراسة جانب منها دون آخر. بمعنى أن الحكمة المتعالية كانت تتجه لتقديم رؤية كاملة من خلال فهم وتحليل جميع جوانبها. لكن الفارق أن الإمام في هذه الرؤية قام بتغيير كيفية التعرض لهذه الجوانب، فأصبح العقل عنده مرحلة، وليس جانباً يطل من خلاله بشكل مستقل على النظرية.
من جهة أخرى أود التذكير هنا برسالة الإمام الخميني (قدس سره) الى غورباتشوف، اذ طلب منه وهو يسعى لإصلاح الاتحاد السوفياتي، أن يدرس تآليف صدر المتألهين وابن عربي ويحقق فيهما، وفي هذا دلالة واضحة على ان المنهج اليقيني لا يتم إلا عبر أدوات كانت الأيديولوجية تلك غافلة عنها، وتجلت بشكل واضح في مدرستي صدر المتألهين وابن عربي، حيث كان الكشف والشهود الباطني هو المرحلة الأهم.. هذه المرحلة بكامل مقدساتها، بالأخص الوحي، كانت تشكل الحجر الأساس نحو البناء العقيدي والأيديولوجي.
أخيراً، ان دراسة متأنية لمنهج الإمام (قدس سره) ستقودنا من دون شك لاكتشاف العلوم والمعارف التي عمل على معالجتها، بدءاً من القرآن الكريم مخزن العلوم والمعارف الحقيقية، فكيف تعامل الإمام (قدس سره) مع هذا الكتاب السماوي، وما هو المنهج الذي أقبل بواسطته عليه، هل كان الإمام مجرد مفسّر يقوم بإعطاء كل كلمة معناها اللغوي أم غير ذلك؟ ثم العرفان المنظم الذي تحكمه الشريعة، حيث اتخذ الإمام منحى مغايراً لما تعارف عليه أكثر العرفاء، فكانت الطريقة عين الشريعة عنده، لا اختلاف بينهما، والشريعة بكامل محتوياتها توصل الى الحقيقة، ومن هنا يمكن الإطلالة على العرفان الحقيقي عند الإمام.
ثم ننتقل الى العلوم العقلية عند الإمام، وهي التي أولاها أهمية بالغة وكبيرة، لأنها مقدمة ضرورية للوصول الى العلوم الحقيقية.. هكذا عندما سبر الإمام غور العلوم والمعارف واستخرج مكنوناتها، كان همّه الوصول الى الحقيقة، وهي تدور مدار اليقين والواقعية..


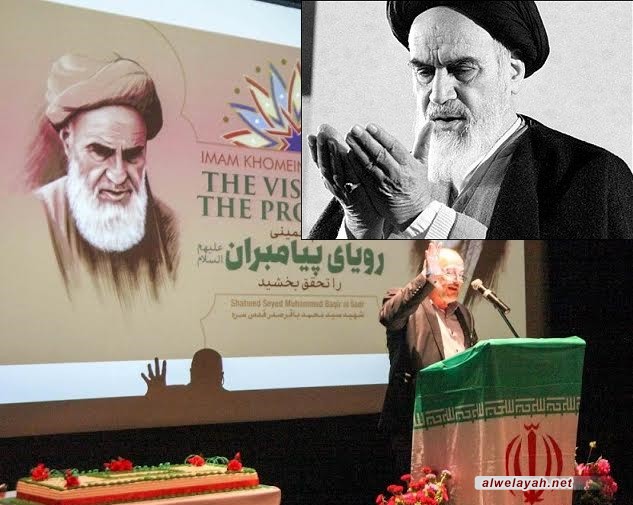




















تعليقات الزوار