بالسَّنَدْ المُتَّصِلِ إِلى مُحمَّد بِنْ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْراهيمَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبِي المَغْرا، عَنْ يَزِيدَ بْن خَلِيفَةَ قالَ: قال أَبُو عَبْدِاللهِ عليه السلام: «كُلُّ رياء شِركٌ، إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ وَمَنْ عَمِلَ للهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللهِ» ([1]).
الشرح:
اعلم أن الرياء هو عبارة عن إظهار وإبراز شيء من الأعمال الصالحة أو الصفات الحميدة أو العقائد الحقة الصحيحة، للناس لأجل الحصول على منزلة في قلوبهم والاشتهار بينهم بالصلاح والاستقامة والأمانة والتدين، من دون أن تكون هناك نية إلهية صحيحة. وهذا الأمر يتحقق في عدة مقامات.
المقام الأول: وله درجتان:
الأولى: وهي أن يظهر العقائد الحقة والمعارف الإلهية، من أجل أن يشتهر بين الناس بالديانة، ومن أجل الحصول على منزلة قي القلوب، كأن يقول: «إني لا أعتبر أن هناك مؤثرا في الوجود إلا الله»، أو أن يقول: «إني لا أتوكل على أحد سوى الله» أو أن يثني على نفسه كناية أو إشارة بامتلاك العقائد الحقة، وهذا الأسلوب هو الأكثر رواجا. فمثلا عندما يجري حديث عن التوكل أو الرضا بقضاء الله، يجعل الشخص المرائي نفسه في سلك أولئك الجمع بواسطة تأوّهه أو هزّ رأسه.
الثانية: وهي أن يبعد عن نفسه العقائد الباطلة وينزه نفسه عنها، لأجل الحصول على الجاه والمنزلة في القلوب، سواء أكان ذلك بصراحة القول أم بالإشارة والكتابة.
المقام الثاني: وفيه أيضا مرتبتان:
إحداهما: أن يظهر الخصال الحميدة والملكات الفاضلة، والأخرى: أن
يتبرأ مما يقابلها، وأن يزكّي نفسه للغاية نفسها التي أصبحت معلومة.
المقام الثالث: وهو الرياء المعروف عند الفقهاء الماضين ـ رضوان الله عليهم ـ وله أيضاً نفس تلكما الدرجتين، إحداهما: أن يأتي بالأعمال والعبادات الشرعية، أو أن يأتي بالأمور الراجحة عقلاً، بهدف مراءاة الناس وجلب القلوب، سواء أن يأتي بالعمل نفسه بقصد الرياء، وبكيفيته، أو شرطه أو جزئه بقصد الرياء على الشكل المذكور في الكتب الفقهية. ثانيهما: أن يترك عملاً محرماً أو مكروهاً بنفس الهدف المذكور.
ونحن نشرح في هذه الأوراق، بعضاً من مفاسد كلّ واحد من هذه المقامات الثلاثة ونشير إلى ما يبدو علاجاً لها على نحو الاختصار.
المقام الأول: الرياء
وفيه عدة فصول
فصل:
اعلم أن الرياء في أصول العقائد والمعارف الإلهية أشد من جميع أنواع الرياء عذاباً وأسوأها عاقبة، وظلمته أعظم وأشد من ظلمات جميع أنواع الرياء. وصاحب هذا العمل إذا كان في واقعه لا يعتقد بالأمر الذي يظهره، فهو من المنافقين، أي أنه مخلَّد في النار، وأن هلاكه أبديّ، وعذابه أشدّ العذاب.
وأما إذا كان معتقداً بما يظهر، لكنه يظهر من أجل الحصول على المنزلة والرتبة في قلوب الناس، فهذا الشخص وإن لم يكن منافقاً إلاّ أن رياءه ي ؤدي إلى اضمحلال نور الإيمان في قلبه، ودخول ظلمة الكفر إلى قلبه، فإن هذا الشخص يكون مشركا في الخفاء، لأن المعارف الإلهية والعقائد الحقة، التي يجب أن تكون خالصة لله، ولصاحب تلك الذات المقدسة، قد حوّلها ـ المرائي ـ إلى الناس، وأشرك فيها غيره، وجعل الشيطان متصرفاً فيه، فهذا القلب ليس لله.
ونحن سنذكر في أحد الفصول؛ أن الإيمان من الأعمال القلبية، وليس هو مجرد علم، وقد جاء في الحديث الشريف: «كُلُ رِيَاءٍ شِرْكٌ».
ولكن هذه الفجيعة الموبقة، وهذه السريرة المظلمة، وهذه الملكة الخبيثة، تؤدي بالإنسان في النهاية، إلى أن تصبح دار قلبه مختصة بغير الله، وتؤدي ظلمة هذه الرذيلة بالإنسان تدريجياً إلى الخروج من هذه الدنيا بدون إيمان.
وهذا الإيمان الذي يمتلكه هو صورة بلا معنى، وجسد بلا روح، وقشر بلا لب، ولا يكون مقبولاً عند الله تعالى، كما أشير إليه في حديث مذكور ف كتاب الكافي، عن علي بن سالم، قال: «سَمِعْتُ أبا عَبْدِاللهُ عليه السّلام يقولُ: قالَ اللهِ عزَّ وجلَّ: أَنَا خُيْرُ شَرِيكٍ مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غيرِي فِي عَمَل عَمِلَهُ لَمْ أَقْبَلُهُ إلاّ مَا كَانَ لِي خَالِصاً» ([2]).
وبديهي أن الأعمال القلبية في حال عدم خلوصها لا تصبح مورداً لتوجه الحق تعالى ولا يتقبلها بل يوكلها إلى الشريك الآخر، الذي كان يعمل له ذلك الشخص مراءاة. إذاً فالأعمال القلبية تصبح مختصة بذلك الشخص، وتخرج من حدّ الشرك، وتدخل إلى الكفر المحض. بل ويمكن القول إن هذا الشخص هو من جملة المنافقين. وكما أن شركه خفي فنفاقه خفي أيضاً، فهذا المسكين يتصور أنه مؤمن ولكنه مشرك منذ البداية، وفي النتيجة هو منافق. وعليه أن يذوق عذاب المنافقين، وويل للذي ينتهي عمله إلى النفاق.
فصل: في بيان أن العلم يغاير الإيمان
اعلم أن الإيمان غير العلم بالله ووحدانيته وسائر الصفات الكمالية الثبوتية والجلالية السلبية، والعلم بالملائكة والرسل والكتب ويوم القيامة. وما أكثر من يكون له هذا العلم ولكنه ليس بمؤمن. الشيطان عالم بجميع هذه المراتب بقدر علمنا وعلمكم، ولكنه كافر. بل إن الإيمان عمل قلبي، وما لم يكن ذلك فليس
هناك إيمان. فعلى الشخص الذي علم بشيءٍ عن طريق الدليل العقلي أو ضروريات الأديان، أن يسلّم لذلك قلبه أيضاً، ولأن يؤدي العمل القلبي الذي هو نحو من التسليم والخضوع، ونوع من التقبل والاستسلام ـ عليه أن يؤدي ذلك ـ لكي يصبح مؤمناً.
وكمال الإيمان هو الاطمئنان. فإذا قوي نور الإيمان تبعه حصول الاطمئنان في القلب، وجميع هذه الأمور هي غير العلم. فمن الممكن أن يدرك العقل بالدليل شيئا لكن القلب لم يسلم بعد، فيكون العلم بلا فائدة. مثلاً أنتم أدركتمبعقولكم أن الميت لا يستطيع أن يضرّ أحداً، وأن جميع الأموات في العالم ليس لهم حس ولا حركة بقدر ذبابة، وأن جميع القوى الجسمانية والنفسانية قد فارقته ولكن حيث أن القلب لم يتقبل هذا الأمر ولم يسلم أمره للعقل، فإنكم لا تقدرون على مبيت ليلة مظلمة واحدة مع ميت!!
وأما إذا سلّم القلب أمره للعقل، وتقبل هذا الحكم منه، فلن يكون في هذا العمل ـ أي المبيت مع الميت ـ أي إِشكال بالنسبة إليكم، كما أنه وبعد عدة مرات من الإقدام، يصبح القلب مسلّماً، فلن يبقى عنده بعدها بأس أو خوف من الميت.
إذاً؛ أصبح معلوماً أن التسليم ـ وهو من حظ القلب ـ غير العلم الذي هو من حظ العقل.
ومن الممكن أن يبرهن إنسان بالدليل العقلي، على وجود الخالق تعالى والتوحيد والمعاد وباقي العقائد الحقة ولكن هذه العقائد لا تسمى إيمانا، ولا تجعل الإنسان مؤمنا، وإنما هو من جملة الكفار أو المنافقين أو المشر كين. فاليوم العيون مغشّاة، والبصيرة الملكوتية غير موجودة، والعين الملكية لا تُدرك، ولكن عند كشف السرائر، وظهور السلطة الإلهية الحقة، وخراب الطبيعة وانجلاء الحقيقة، سيعرف ويلتفت بأن الكثيرين لم يكونوا مؤمنين بالله حقا، وأن حكم العقل لم يكن مرتبطا بالإيمان، فما لم تكتب عبارة «لا إله إلا الله» بقلم العقل على لوح القلب الصافي لن يكون الإنسان مؤمنا بوحدانية الله.
وعندما ترد هذه العبارة النورانية الإلهية على القلب، تصبح سلطة القلب لذات الحق تعالى، فلا يعرف الإنسان بعدها شخصا آخر مؤثرا في مملكة الحق، ولا يتوقع من شخص آخر جاها ولا جلالا، ولا يبحث عن المنزلة والشهرة عند الآخرين.
ولا يصبح القلب مرائيا ولا مخادعا حينئذ. وإذا رأيتم رياء في قلوبكم، فاعلموا أن قلوبكم لم تسلّم للعقل، وأن الإيمان لم يقذف نوره فيها، وأنكم تعدون شخصا آخر إلها ومؤثرا في هذا العال، لا الحق تعالى، وأنكم في زمرة المنافقين أو المشركين أو الكفار.
فصل: في وخامة أمر الرياء
تأمل أيها الشخص المرائي... يا من أودعت العقائد الحقة والمعارف الإلهية بيد عدو الله، وهو الشيطان، وأعطيت ما هو مخصوص بالحق تعالى للآخرين، وبدّلتَ تلك الأنوار التي تضيء الروح والقلب وهي رأسمال النجاة والسعادة الأبدية ومنبع اللقاء الإلهي وبذرة القرب من المحبوب أبدلتها بظلمات موحشة وشقاء أبدي وجعلتها رأسمال البُعد والابتعاد عن ساحة المحبوب المقدسة، والابتعاد عن لقاء الله تعالى.
تهيأ، أيها المرائي، للظلمات التي لا نور بعدها، وللشدائد التي لا فرج لها، وللأمراض التي لا يرجى شفاؤها، وللموت الذي لا حياة معه، وللنار تخرج من باطن القلب فتحرق ملكوت النفس وملك البدن حرقاً لم يخطر على قلبي وقلبك، والتي يخبرنا عنها الله تعالى في كتابه المنزل في الآية الشريفة {نَارُ اللَّهِ الْ مُوقَدَةُ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ}([3]). حيث تحدثت عن نار الله، هذه النار التي تتسلط على القلوب فتحرقها، وليست هناك نار تحرق سوى النار الإلهية فإذا فقدت فطرة التوحيد ـ وهي فطرة الله ـ وحلَّ محلها الشرك والكفر، حينئذ لن تكون شفاعة الشافعين من نصيب الإنسان بل يخلد الإنسان في العذاب، وما أدراك ما العذاب؟ إنه العذاب الذي ينبعث عن الغضب الإلهي.
إذاً أيها العزيز... من أجل خيال باطل ومحبوبية بسيطة في أعين العباد الضعاف، ومن أجل جذب قلوب الناس المساكين، لا تعرض نفسك للغضب الإلهي، ولا تبع ذلك الحب الإلهي وتلك الكرامات غير المحدودة، وتلك الألطاف والعنايات الربانية، لا تبعها بمحبة بسيطة عند مخلوق ليس له أثر، ولا تكسب منه أيّة ثمرة سوى الندامة والحسرة، عندما تقصر يداك عن هذا العالم ـ وهو عالم الكسب ـ، وعندما ينقطع عملك، وليس للندم حينئ نتيجة ولا للإنابة من فائدة.
فصل: تنبيه علمي لاستئصال جذور الرياء
نذكر هنا أمراً نأمل أن يكون مؤثراً في علاج هذا المرض القلبي سواء في هذا المقام أو المقامات الأخرى، وهذا الأمر مطابق للبرهان ـ الدليل ـ والمكاشفة والعيان وأخبار المعصومين وكتاب الله، وللعقل حيث يصدق عقول الناس.
وهو أنه نتيجة لإحاطة قدرة الله تبارك وتعالى بجميع الموجودات، وبسطة لسلطانه على جميع الكائنات، وإحاطة قيمومته بجميع الممكنات، فإن قلوب العباد جميعا تكون تحت تصرفه وبيد قدرته وفي قبضة سلطانه، ولا يتصرف ـ ولن يتصرف ـ أحد في قلوب العباد بدون أذنه القيومي وإجازته التكوينية. وحتى أصحاب القلوب أنفسهم ليست لهم القدرة على التصرف في قلوبهم بدون إذن من الله تعالى. وبهذا المعنى وردت كلمات، إشارة وكناية وصراحة في القرآن وفي أخبار أهل البيت «عليهم السلام».
إذاً، فالله تعالى هو مالك القلب وا لمتصرف فيه وأما العبد الضعيف العاجز فلا يستطيع أن يتصرف بقلبه بدون إذنه، بل إن إرادته قاهر لإرادتك ولإرادة جميع الموجودات. إذن فرياؤك وتملقك، إذا كانا لأجل جذب قلوب العباد، ولفت نظرهم، ومن أجل الحصول على المنزلة والتقدير في القلوب والاشتهار بالصلاح، فإن ذلك خارج كلية عن تصرفك، وهو تصرف الله، فإله القلوب وصاحبها يوجه القلوب نحو من يشاء بل من الممكن أن تحصل على نتيجة عكسية. وقد رأينا وسمعنا أن أشخاصا متملقين ومنافقين ممن لم تكن لهم قلوب طاهرة، قد افتضحوا وبان زيفهم ففرض عل يهم عكس ما أرادوا الحصول عليه من النتائج في نهاية
الأمر. لقد وردت الإشارة إلى هذا المعنى في الحديث الشريف في الكافي: «عن جرّاحٍ المَدائني، عَنْ أبي عَبْدِالله عليه السّلام في قَوْلِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}([4])..» قال عليه السلام: الرَّجُلُ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّوابِ لاَ يَطْلبُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِنَّما يَطْلُبُ تَزْكِيَةَ النَّاسِ يَشْتَهي أَنْ يَسْمَعَ به النَّاسُ فَهذا الَّذي أَشْرَكَ بِعِبَادةِ رَبّه. ثُمَّ قال: «مَا مِنْ عبد أَسَرَّ خَيْراً فَذَهَبَتِ الأَيّامُ أَبَداً حتى يُظْهِرَ اللهُ لَهُ خَيْراً، وَمَا مِنْ عَبْدٍ أسرَّ شَرّاً فَذَهَبَتِ الأَيّامُ أَبداً حَتَّى يُظْهِرُ اللهُ لَهُ شَراً» ([5]).
إذاً أيها العزيز، أطلب السمعة والذكر الحسن من الله، التمس قلوب الناس من مالك القلوب، أعمل أنت لله وحده فستجد أن الله تعالى ـ فضلاً عن الكرامات الأخروية ونعم ذلك العالم ـ سيتفضل عليك في هذا العالم نفسه بكرامات عديدة، فيجعلك محبوباً، ويعظم مكانتك في القلوب، ويجعلك مرف وع الرأس ـ وجيهاً ـ في كلتا الدارين. ولكن إذا استطعت فخلّص قلبك بصورة كاملة بالمجاهدة والمشقة، من هذا الحب أيضاً، وطهِّر باطنك، كي يكون العمل خالصا من هذه الجهة، ويتوجه القلب إلى الله فقط حتى تطهر الروح، وتزول أدران النفس. فأية فائدة تجني من حب الناس الضعاف لك، أو بغضهم، أو من الشهرة والصيت عند العباد وهم لا يملكون شيئا من دون الله تعالى؟ وحتى لو كانت له فائدة ـ على سبيل الفرض ـ فإنما هي فائدة تافهة ولأيام معدودات، ومن الممكن أن يسوق هذا الحب عاقبة عمل الإنسان إلى الرياء، وأن يجعل الإنسان ـ لا سمح الله ـ مشركا ومنافقا وكافرا. وأنه إذا لم يفتضح في هذا العالم، فسيفتضح في ذلك العالم في محضر العدل الرباني، عند عباد الله الصالحين وأنبيائه العظام وملائكته المقربين، ويهان ويصبح مسكينا. إنها فضيحة ذلك اليوم، وما أدراك ما تلك الفضيحة، والله يعلم أي ظلمات تلي تلك المهانة في ذلك المحضر! إن ذلك اليوم ـ كما يقول الله تعالى في كتابه ـ يتمنى الكافر فيه قائلا: {يَالَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا}([6]).، ولكن لا جدوى لهذا التمني.
أيها المسكين، إنك ولأجل محبة بسيطة، جزئية، ومنزلة عديمة الفائدة بين العباد، تجاوزت تلك الكرامات وفقدت رضا الله، وعرضت نفسك لغضب الله.
لقد استبدلت الأعمال التي كان ينبغي أن تهيئ بها دار الكرامة في الآخرة، وتوفر الحياة السعيدة الدائمة وتصل بواسطتها إلى أعلى عليين في الجنان استبدلتها بظلمات الشرك والنفاق وأعددت لنفسك الحسرة والندامة والعذاب الشديد، وجعلت نفسك من أهل «سِجِّين»، بالصورة التي وردت في الحديث الشريف في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام: «قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيهِ وآلِهِ وَسَلَّم: إِنَّ المَلَكَ لَيَصْعَدُ يِِعَمَل العَبْدِ مُبْتَهِجَاً بِهِ فَإِذا صَعَدَ بِحَسَنَاتِهِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، اجُعَلوهَا فِي سّجِّينٍ، إِنَّهُ لَيْسَ إِيايَ أَرَادَ بِهَا» ([7]).
إننا هنا وفي هذا الحال، لا نستطيع أن نتصور «سجين» ولا أن نفهم ديوان، عمل «الفُجّارِ»، ولا أن نرى صور هذه الأعمال وهي في سجين.. وسنرى حقيقة الأمر في أحد الأيام ولكن عندها تقصر أيدينا عن العمل ولا سبيل حينئذ للنجاة.
أيها العزيز.. ! استيقظ وأبعد عنك الغفلة والسكرة وزن أعمالك بميزان العقل قبل أن توزن في ذلك العالم، وحاسب نفسك قبل أن تُحاسب، وآجلُ مرآة القلب من الشرك والنفاق والتلوّن، ولا تدع صدأ الشرك والكفر يحيط به بمستوىً لا يمكن جلاؤه حتى بنيران ذلك العالم، لا تدع نور الفطرة يتبدل بظلمة الكفر، لا تدع هذه الآية {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاَ عَلَيْهَا..} ([8]).. أن تضيع لا تخنْ هذه الأمانة الإلهية بهذا النحو، نظّف مرآة قلبك لكي يتجلّى فيها نور جمال الحق فيغنيك عن العالم وكل ما فيه. ولكي تتوهج نار الحب ـ العشق ـ الإلهي في قلبك، فتحرق الأنواع الأخرى من الحب، ولا تستبدل حينذاك جميع هذا العالم بلحظة واحدة من الحب الإلهي، ولكن تحصل على لذة في مناجاة الله وذكره، تعتبر غيرها من جميع اللذات الحيوانية، لعباً ولهواً. وإذا لم تكن من أهل هذه العوالم، وترى هذه المعاني غريبة وعجيبة لديك فإياك أن تضيع تلك النعم الإلهية في العالم الآخر المذكورة في القرآن المجيد وأخبار المعصومين عليهم السلام وتخسرها من أجل جذب قلوب المخلوقين... لا تُضيّع كل هذا الثواب من أجل شهرة وهمية في أيام معدودات، لا تحرم نفسك من كل هذه الكرامات، لا تبع السعادة الأبدية بالشقاء الدائم.
فصل: في الدعوة إلى الإخلاص
إعلم أن مالك الملوك الحقيقي وولي النعمة الواقعي، الذي تفضّل علينا بكل هذه الكرامات، وهيأ لنا كل هذه النعم، قبل المجيء إلى هذا العالم، من الغذاء الطيب ذي المواد النافعة المناسبة لمعدتنا الضعيفة، ومن المربّي الخادم بلا منّة بل بفعل الحب الفطري الذاتي. وهيأ لنا البيئة والهواء المناسبين وباقي النعم العظيمة الظاهرة والباطنة. كما أعدَّ لنا الكثير في العالم الآخر وفي البرزخ قبل ذهابنا إلى هناك، هذا المتفضل قد طلب منا قائلا:
«أخلص قلبك لي ولأجل كرامتي، كي تحصل أنت على النتيجة، وتحصل أنت على الفائدة» ومع ذلك لا يلقى منا أذناً صاغية بل يرى التمرد والسير على خلاف رضاه، فأي ظلم عظيم نكون قد اجترحناه بذلك؟! وأي مالك الملوك نحارب؟! ونتيجة ذلك كله تكون وبالاً علينا نحن، أما الله تعالى فلا يصاب سلطانه بضرر ولا ينقص من ملكه شيء ولا نخرج من سلطنته وسلطت، حتى إذا كنا مشتركين لأننا ألحقنا الضرر بأنفسنا، {... فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ}([9]). فهو غني عن عبادتنا وإخلاصنا وعبوديتنا، ولا يؤثر تمرّدنا وشركنا وابتعادنا عنه شيئاً في مملكته، وحيث أنه أرحم الراحمين فقد اقتضت رحمته الواسعة وحكمته البالغة أن يعرض لنا طريق الهداية وسبيل الخير والشر والحسن والقبح ويدلنا على زلاّت طريق الإنسانية، ومزالق طريق السعادة، ولله تعالى في هذه الهداية والإرشاد بل في هذه العبادات والإخلاص والعبودية، له سبحانه علينا منن عظيمة وجسيمة بحيث لا يمكن أن نفهمها ما لم تنفتح عين البصيرة والبرزخية التي ترى الواقع، وما دمنا في هذا العالم الضيق والمظلم، وفي ظلام الطبيعة، وما دمنا مقيدين بسلاسل الزمان، معتقلين في هذا المكان السجن المظلم فإنّا لا ندرك منن الله العظيمة علينا، ونتخيل بأن نعم الله علينا تتلخص في هذا الإخلاص وهذه العبادة، وفي ذلك الإرشاد وتلك الهداية فحسب.
لا تتوهم أبدا أن لنا المنة على الأنبياء العظام والأولياء الكرام على علماء الأمة وهم الأدلاّء إلى سعادتنا ونجاتنا، والذين أنقذونا من الجهل والظلمة والشقاء، أخذونا إلى عالم النور والسرور والبهجة والعظمة والذين تحملوا ولا يتحملون كل هذه المشاق والمصاعب من أجل تربيتنا وإنقاذنا من تلك الظلمات التي تلازم الاعتقادات الباطلة، ومن الجهل المركب بكل أشكاله، ومن أنواع الضغوطات والعذاب الذي هو صورة الملكات والأخلاق الرذيلة، ومن تلك الصور الموحشة والمرعبة التي هي ملكوت أعمالنا وأفعالنا القبيحة ـ وكذلك ـ لأجل إيصالنا إلى تلك الأنوار وأنواع البهجة والسرور والراحة والأنس والنعيم والحور والقصور التي لا نقدر أن نتصورها، حيث أن عالم الملك هذا مع كل ما له من عظمة، أضيق من أن يحتوي على واحدة ن حُلل الجنة، وأن أعيننا لا تطيق رؤية شعرة واحدة من شعر حور العين، وتكون كل هذه المثوبات صورا ملكوتية لتلك العقائد والأعمال والتي أدركها الأنبياء العظام، خصوصا صاحب الكشف الكلي والكتاب الجامع خاتم الأنبياء صَلّى الله عَلَيهِ وآلِهِ وَسَلَّم، أدركوها بالوحي الإلهي ورأوها وسمعوها ودعونا إليها. ونحن المساكين كالأطفال، المتمردين على حكم العقلاء بل المخطئين لهم، قد واجهناهم دائما بالعناد والمحاربة والانفصال، ولكن تلك النفوس الزكية والأرواح الطيبة الطاهرة ـ الأنبياء ـ بما يكمن فيهم من الرأفة والرحمة بعبادة الله، لم يقصّروا أبدا في دعوتهم، على الرغم من جهلنا وعنادنا، بل ساقونا نحو الجنة والسعادة بكل ما يملكون من القوة وأساليب الدعوة أن ينتظروا منا جزاءً ولا شكورا.
وحتى عندنا يحدد الرسول الأكرم صَلّى الله عَلَيهِ وآلِهِ وَسَلَّم أجره بـ «المودَّة في القُرْبَى»، فإن صورة هذه المودة في العالم الآخر قد تكون بالنسبة إلينا أعظم الصور نورا وعطاءا. وهذا هو أيضا من أجلنا نحن ومن أجل وصولنا إلى السعادة
والرحمة. إذاً، فأجر الرسالة عائد إلينا أيضا، ونحن الذين ننتفع به، فأية منّة لنا نحن المساكين عليهم؟!... وأية فائدة تعود عليهم ـ سلام الله عليهم ـ من إخلاصنا لهم وتعلقنا بهم؟!... أية منّة لكم ولنا على علماء الأمة؟ بدءاً من ذلك العالم الذي يوضح ويبين لنا الأحكام الشرعية، إلى النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم وإلى ذات الله المقدسة جلَّ جلاله فإن لكل منهم حسب درجته ومقامه من حيث إرشادهم لنا إلى طريق الهداية مِنَناً لا نستطيع مكافأتهم عليها في هذا العالم، فهذا العالم لا يليق بجزائهم... {فَلِلَّهِ وَلرَسُولهِ وَلأولِيَائِهِ المنّة} وكما يقول تعالى: {... قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُْ بَلْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}([10]). إذاً، فإن كنّا صادقين في ادعاء الإيمان، فلله المنّة علينا في هذا الإيمان نفسه. فالله بصير وعالم بالغيب، وهو يعلم ماهية صور أعمالنا، وكيفية صورة إيماننا وإسلامنا في عالم الغيب. أما نحن المساكين حيث لا نعرف الحقيقة، فإننا نتعلم العلم من العالم ونمنّ عليه، ونصلّي جماعة مع العالم ونمنّ عليه، مع أن لهم المنّة علينا ونحن لا نعلم. بل وإن هذه المنّة التي نمنُّ بها عليهم هي التي تحبط أعمالنا وتجرّها إلى «سجين»، وتذروها في الهواء لكي تفني وتذهب.
المقام الثاني: الرياء
وفي فصلان:
الفصل الأول: الرياء في العمل
اعلم أن الرياء في هذا المقام، وإن لم يكن بحجم المقام الأول ـ من الدفع نحو الكفر ـ إلاّ أنه، بعد الالتفات إلى موضوعه، قد يفضي بعمل المرائي أيضا في هذا المقام (العمل) إلى الكفر فيصبح واحدا في النتيجة مع عمل المرائي في ذلك المقام: مقام الرياء في العقيدة.
لقد أوضحنا في شرح الحديث السابق، أنه يمكن أن تكون للإنسان في عالم الملكوت صورة تغاير الصورة الإنسانية، وأن تلك الصور تتبع ملكوت النفس وملكاتها، فإذا كنتم ذوي ملكات فاضلة إنسانية، فستجعل هذه الملكات صوركم، إنسانية عندنا يحشر الإنسان ومعه تلك الملكات ما لم تخرج عن طريق الاعتدال، بل إن الملكات إنما تكون فاضلة حين لا تتصرف النفس الأمارة بالسوء فيها، ولا يكون لخطوات النفس دور في تشكيلها.
يقول أستاذنا الشيخ محمد علي الشاه آبادي دام ظله: «إن المعيار في الرياضة الباطلة والرياضة الشرعية الصحيحة هو خطى النفس وخطى الحق، فإذا كان تحرك السالك بخطى النس وكانت رياضته من أجل الحصول على قوى النفس وقدرتها وتسلطها، كانت رياضته باطلة وأدى سلوكه إلى سوء العاقبة. وتظهر الدعاوى الباطلة ـ عادة ـ من مثل هؤلاء الأشخاص».
أما إذا كان تحرك السالك بخطى الحق وكان باحثا عن الله، فإن رياضته هذه حقّه وشرعية وسيأخذ الله تعالى بيده ويهديه كما تنص على ذلك الآية الشريفة التي تقول: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا...}([11]). وسيؤول عمله إلى السعادة. فتسقط عنه «الأنا» ويزول عنه الغرور. ومعلوم أن خطوات الشخص الذي يعرض أخلاقه الحسنة وملكاته الفاضلة على الناس ليلفت أنظارهم إليه هي خطوات النفس، وهو متكبر وأناتي ومعجب بنفسه، وعابد لها.
ومع التكبر تكون العبودية لله وهماً ساذجاً، وأمراً باطلا ومستحيلا، وما دامت مملكة وجودكم مملوءة يجب النفس وحب الجاه والجلال والشهرة والترأس على عباد الله، فلا يمكن اعتبار ملكاتكم ملكات فاضلة، ولا أخلاقكم أخلاقا إلهية. فالفاعل في مملكتكم هو الشيطان، وليس ملكوتكم وباطنكم على صورة إنسان. وعند فتح العيون البرزخية، ترون ملكوتكم على غير صورة الإنسان، وإنما هي صورة أحد الشياطين مثلا. وحصول المعارف الإلهية والتوحيد الكامل أمر مستحيل بالنسبة إلى قلب كهذا ما دام مسكنا للشيطان، وما دام ملكوتكم غير إنساني، وما دامت قلوبكم غير مطهرة من هذه الانحرافات والأنانيات.
ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «لا تسعني أَرْضِي وَلاَ سَمَائِي، بَلْ يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِي المُؤْمِنِ» ([12]) ليس موجود يكون آية جمال المحبوب سوى قلب المؤمن. إن المتصرف في قلب المؤمن هو الله، لا النفس. الفاعل ي وجوده هو المحبوب، فلا يكون قلب المؤمن متمردا ولا تائها.
«قَلْبُ المُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَي الرَّحْمنِ يُقَلِّبِه كَيْفَ يَشَاء» ([13])
وأنت أيها المسكين العابد للنفس، والذي تركت الشيطان والجهل يتصرفان في قلبك، ومنعت يد الحق أن تتصرف في قلبك، أيّ إيمان لديك حتى تكون محلا لتجلّي والسلطة المطلقة؟
فاعلم إذاً، أنك ما دمت على هذه الحال، وما دامت رذيلة الغرور موجودة فيك، فأنت كافر بالله، معدود من زمرة المنافقين، رغم زعمك بأنك مسلم ومؤمن بالله.
الفصل الثاني: خلق الله الإنسان لنقسه سبحانه
أيها العزيز! استيقظ وانتبه وافتح أذنيك، وحرّم نوم الغفلة على عينيك، واعلم أن الله خلقك لنفسه كما يقول في الحديث القدسي:
«يا بنَ آدَمَ خَلَقْتُ الأَشْيَاءَ لأَجْلِكَ وَخَلَقْتُكَ لأَجْلِي» ([14]) واتخذ من قلبك منزلا له، فأنت وقلبك من النواميس والحرمات الإلهية، والله تعالى غيور، فلا تهتك حرمته وناموسه إلى هذا الحدّ، ولا تدع الأيادي تمتد إلى حرمه وناموسه. احذر غيرة الله، وإلا فضحك في هذا العالم بصورة لا تستطيع إصلاحها مهما حاولت. أتهتك في ملكوتك وفي محضر الملائكة والأنبياء العظام ستر الناموس الإلهي؟ وتقدم الأخلاق الفاضلة التي تخلَّق بها الأولياء إلى الحق، إلى غير الحق؟ وتمنح قلبك لخصم الحق؟ وتشرك في باطن ملكوتك؟ كن على حذر من الحق تعالى فإنه مضافاً إلى هتكه سبحانه لناموس مملكتك في الآخرة ـ وفضحه لك أمام الأنبياء العظام والملائكة المقربين، سيفضحك في هذا العالم ويبتليك بفضيحة لا يمكن تلافيها... وبتمزيق عصمة لا يمن ترقيعها.
إن الحق تعالى «ستارُ» ولكنه غيور أيضا... إنه «أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» ولكنه «أَشَدُّ المَعَاقِبِيَن» أيضا يستر ما لم يتجاوز الحد. فقد تؤدي هذه الفضيحة الكبرى ـ لا سمح الله ـ إلى تغليب الغيرة على الستر، كما سمعت في الحديث الشريف.
فارجع إلى نفسك قليلا، وعد إلى الله، فالله رحيم، وهو يبحث عن ذريعة لإفاضة الرحمة عليك. إذا أنبت إليه، فإنه يستر بغفرانه معاصيك وعيوبك الماضية، ولن يطلع عليها أحداً ويجعلك صاحب فضيلة، ويظهر فيك الأخلاق الكريمة، ويجعلك مرآة لصفاته تعالى ويجعل إرادتك فعّالة في ذلك العالم كما أن إرادته نافذة في جميع العوالم. كما ورد في حديث منقول: إن أهل الجنة عندما يستقرون في الجنة، تبلغهم رسالة من الحق تعالى خلاصتها: من الحي الأبدي الذي لا يموت، إلى الحي الأبدي الذي لا يموت إذا أردتُ شيئاً قلتُ له كن فيكون، جعلتك هذا اليوم في مستوىً إذا أردتَ شيئاً قلت كن فيكون.
لا تكن محباً لنفسك، سلّم إرادتك للحق تعالى، فإن الذات المقدسة يتفضل عليك بجعلك مظهراً لإرادته، ويجعلك متصرفاً في كافة الأمور. ويخضع لقدرتك مملكة الإيجاد. وهذا هو غير التفويض الباطل، كما هو معلوم في محله.
فيا أيها العزيز. أنت أعرف بنفسك فاختر إمّا هذا وإمّا ذاك فالله غنيٌّ عنّا وعن كل المخلوقات إنه غنيٌّ عن إخلاصنا وإخلاص كل الموجودات.
المقام الثالث: الرياء
وفيه فصول
فصل: تلاعب الشيطان مع الناس من خلال المناسك والعبادات
إعلم أن الرياء في هذا المقام، أكثر من المقامات الأخرى وأوسع شيوعاً، إذ أننا نحن العامة من الناس، لسنا على العموم أهلاً لذينك المقامين. ولهذا لا يدخل الشيطان إلينا من ذلك الطريق، ولكن بما أن معظم الناس المتعبدين، هم من أهل المناسك والعبادات الظاهرية، فإن الشيطان أثر حرية في التلاعب بهم، في هذا المقام ومن خلال العبادات.
كما أن مكائد النفس في هذه المرحلة أكثر. وبتعبير آخر: بما أن عامة الناس؛ يفوزون بالجنة بالأعمال الجسمانية، أنهم يحصلون على الدرجات الأخروية بممارسة الأعمال الحسنة وترك الأعمال السيئة، فإن الشيطان يدخل عليهم من هذا الطريق نفسه، ويسقى جذور الرياء والتملق في أعمالهم، فتفرّع وتورق، ويبدل حسناتهم سيئات، ويدخلهم جهنم ودركاتها عن طريق المناسك والعبادات، ويحوّل الأمور التي يريدون أن يعمّروا بها آخرتهم إلى أدوات لتخريبها ـ الآخرة فيجعل الملائكة ما هو ـ الأعمال ـ من العليين بأمر من الله في سجين.
فعلى الذين يملكون هذا الجانب فقط، ولا زاد لهم سوى زاد الأعمال، عليهم أن يكونوا حذرين كل الحذر لئلا يفقدوا ـ لا سمح الله ـ الزاد والراحلة كليهما، وصبحوا من أهل جهنم، ولا يبقى لهم طريق نحو السعاد ة، وتغلق في وجوههم أبواب الجنة، وتفتح لهم أبواب النار.
فصل: في دقّة أمر الرياء
كثيراً ما يتفق أن يكون الشخص المرائي نفسه غافلاً أيضاً عن كون الرياء قد تسرب إلى أعماله، وأن أعماله صارت رياء وهباء إذ أن مكائد الشيطان والنفس من الدقة والخفاء، وصراط الإنسانية من الرهافة والظلمة بدرجة لا ينتبه الإنسان إلى ما
هو فيه إن لم يكن حذرا جدا. إنه يحسب أن أعماله لله ولكنها تكون في الواقع للشيطان ولما كان الإنسان مجبولاً على حب النفس، فإن حجاب حب النفس يستر عنه معايب نفسه، وقد يأتي بيان بعض ذلك ضمن شرح بعض الأحاديث إن شاء الله، ونسأل منه سبحانه التوفيق على ذلك.
ففي دراسة علوم الدين مثلا ـ وهي من الطاعات والعبادات المهمة ـ يبتلي الإنسان الكامل بالرياء من حيث لا يدري وذلك بسبب الحجاب الغليظ لحب النفس.
إن الإنسان يرغب أن يتفرّد في استيعاب معضة علمية وحلّها لدى محضر العلماء والرؤساء والفضلاء، ويبتهج أكثر، كلما كان توضيحه للمسألة العلمية أحسن، ولفت انتباه الحاضرين أكثر. لأنه يحب أن ينتصر على كل من يناظره. إنه يشعر بنوعٍ من الدلال العلمي والتفوق، وإذا اقترن ذلك بتصديق من إحدى الشخصيات، لكان نور على نور. إن هذا المسكين غافل عن أنه أحرز هنا موقعاً لدى الفضلاء والعلماء ولكنه سقط من عين ربهم ومالك ملوك العالم، وأن عمله قد ترك بأمر الحق المتعال في سجين. ثم إن عمله هذا من الرياء ممزوج بعده معاص أخرى، مثل فضحه وإذلاله وإيذائه أخاً له في الإيمان، وأحياناً التجرؤ على مؤمن وهتكه، وكل واحد من هذه الأعمال هي من الموبقات وكافية وحدها لإدخال الإنسان في جهنم. وإذا ألقت النفس مرة أخرى شباك كيدها، لتقول لك: إن هدفي هو إعلان الحكم الشرعي وإظهار كلمة الحق وهو من أفضل الطاعات، وليس لإظهار العلم والتكبر وحب الظهور، فاسأل نفسك في الباطن أنه لو كان زميلي المساوي لي في الدرجة العلمية هو الذي قال ذلك الحكم الشرعي وهو الذي حلَّ تلك المعضلة وكنتِ أنتِ مغلوبة في ذلك المحضر، أكان ذلك على حدِ سواء عندك؟ إذا كان كذلك فأنت صادق. وإذا لم تترك كيدها وقالت لك: إن إظهار الحق فضيلة، وله ثواب عند الله تعالى، وأنا أريد أن أنال هذه الفضيلة، وأعمّر دار الثواب، فقل لها: لنفرض أن الله تعالى أنعم عليكِ بتلك الفضيلة نفسها في حالة مغلوبيتك وتصديقك بالحق، فهل تبقين طالبة للغلبة؟ فإذا رجعتم إلى باطنكم ورأيتم أنكم ما زلتم تميلون الغلبة، والاشتهار بين العلماء بالعلم والفضل، وأن بحثكم العلمي كان لأجل الحصول على
المكانة في قلوب أولئك، إذاً، فاعلموا أنكم مراءون في هذا البحث العلمي الذي هو من أفضل الطاعات والعبادات وأن عملكم هذا ـ بحسب الرواي الشريفة في كتاب (الكافي) هو في «سجين»، وأنكم مشركون بالله. وإن هذا العمل هو لأجل حبّ الجاه والشرف وهما ـ بحسب الرواية ـ أشد ضررا على الإيمان من ذئبين أُطلقا على قطيع بلا راعٍ.
إذاً، فعليكم أنتم أهل العلم المتكفلين بإصلاح الأمة والإرشاد إلى الآخرة الأطبَّاء للأمراض النفسية، أن تصلحوا أنفسكم أولا وتجعلوا مزاجكم النفسي سالماً، كي لا تكونوا في زمرة «العالم بلا عمل» وهو صنف معلوم الحال والعاقبة.
اللّهم طهّر قلوبنا من كدر الشرك والنفاق، وصفَّ مرآة قلوبنا من صدأ حب الدنيا وهي منشأ جميع هذه الأمور. اللهم رافقنا، وخذ بأيدينا نحن المساكين المبتلين بهوى النفس وحبِّ الجاه والشرف في هذا السفر المملوء بالخطر وفي هذا الطريق المليء بالمنعطفات والصعاب والظلمات إنك على كل شيء قدير.
إن صلاة الجماعة واحدة من العبادات العظيمة في الإسلام، وفضل إمامتها أعظم. ومن هنا فإن الشيطان ينفذ إلى هذه العبادة أكثر، وهو مع الإمام أشد عداوة، ويسعى إلى أن ينتزع منه هذه الفضيلة، ويفرغ عمله من الإخلاص، ويدخله إلى «سجين»، ويجعله مشركا بالله. ولأجل ذلك يدخل الشيطان إلى قلوب بعض أئمة الجماعة بطرق مختلفة مثل: العُجُب (سيأتي بيانه إن شاء الله لا حقا) ومثل: الرياء وهو إظهار هذه العبادة العظيمة، أمام الناس من أجل الحصول على منزلةٍ في قلوب الناس والاشتهار بالعظمة لديهم. فمثلاً يرى إمام الجماعة أن أحد المشهورين بالتقوى والدين قد حضر إلى صلاة جماعته، ولأجل جذب قلبه، يكثر من خضوعه ويلتجأ إلى أساليب مختلفة، وحيل كثيرة لصيده، ومن أجل تعظيم نفسه عند الغائبين الذين لم يحضروا صلاة جماعته، يتحدث في المجالس عن ذلك المتديّن، ويحاول إفهام الناس أن فلانا يأتم به ويشارك في صلاة جماعته. ثم هو أيضا يقابله بالود والح في قلبه، لأجل حضوره في صلاة جماعته ويُكنّ له من الحب والإخلاص ما لم يُكنّ لحظة طوال حياته، لله ولا لأولياء الله، خصوصا إذا كان هذا المتدين من التجار المحترمين. وإذا حدث لا سمح الله أن ضلَّ أحد الأشراف طريقه والتحق بصلاة الجماعة، فإن المصيبة
على إمام الجماعة من وسوسة الشيطان تكون أعظم. إن الشيطان لا يترك حتى إمام جماعة قليلة الأفراد، فيذهب إليه ويوحي له فيوسوس في نفسه: إنني قد أعرضت عن الدنيا، وأقضيها في مسجد صغير، مع الفقراء والمساكين. وهذا أيضا مثل ذاك، أو أسوأ منه، لأنه يثقل قلبه برذيلة الحسد أيضا، فهو فضلا عن كونه لم ينل من الدنيا شيئا يسلبه الشيطان عدّته لآخرته، فيخسر الدنيا والآخرة.
وفي الوقت نفسه لم يرفع الشيطان يده عنّا: أنا وأنت نقصّر في الحضور في صلاة الجماعة ونحمل الهم والأسى لعدم توفر الظروف والمناخ لإقامة صلاة الج ماعة بإمامتنا، فيدفعنا إلى الإساءة إلى جماعة المسلمين والطعن بهم وخلق عيوب للجماعة، ونعد عدم الاشتراك في الجماعة، عزلة، نظهر أنفسنا كأننا زاهدون في الدنيا ومنزّهون عن حب الجاه والذات، في حين أننا أسوأ من كلتا الفئتين السالفتين، فلا نحن نلنا الدنيا الكاملة التي نالتها الطائفة الأولى، ولا دنيا الطائفة الثانية الناقصة. ولا نحن فزنا بالآخرة، مع أننا أيضاً لو أُتيح لنا ما نريد لكنّا أشد من كلتا الطائفتين حباُ للجاه والمال.
والشيطان لا يكتفي بإمام الجماعة وحده فلا تنطفئ شعلة شهوته بجعله ـ إمام الجماعة ـ من أهل النار، بل يدخل إلى صفوف المصلّين المؤمنين، فحيث أن فضيلة الصف الأول أعظم من سائر الصفوف، وأنّ جانب يمين الإمام أكثر فضلا من جانب يساره، فهو يستهدفه أكثر من غيره.
مسكين هذا المتديِّن يجره الشيطان من بيته البعيد ويجلسه في الجانب اليمن من الصف الأول، ثم يوسوس له كي يتباهى على الناس بهذه الفضيلة، إذ لا يدري هذا المسكين ماذا يفعل؟ فيأخذ بإظهار فضله بتفاخر ودلال، ويبرز شركة الباطن فيكون مصيره إلى «سجين» ثم يذهب الشيطان إلي باقي الصفوف ويدفعهم إلى ن يطعنوا من في الصف الأول بالكتابة والإشارة وأن يجعلوا ذلك المتدين المسكين هدفا لسهام الطعن والشتم، معتبرين أنفسهم منزّهين عن مثل أطواره. وأحيانا قد يُرى شخص محترم، خصوصا إذا كان من أهل الفضل والعلم، قد أخذ الشيطان بيده وأجلسه في الصف الأخير، وكأنه يريد أن يقول للحاضرين: إني بمقامي هذا لا ينبغي أن أُصلّي مع شخص كهذا، ولكن لكوني قد أعرضت عن
الدنيا وليس لدي هوى في النفس، فقد جئت بل وجلست في الصف الأخير ولن ألتقي أشخاصا من هذا القبيل في الصف الأول من صلاة الجماعة.
ولا يكتفي الشيطان بالإمام والمأموم، بل يأخذ بزمام بعض ا لمصلين المنفردين عن الجماعة فيقوده من السوق أو المنزل، بدلال وتبختر، إلى زاوية في المسجد، حيث يفرش سجادته منفردا، دون أن يرى أي إمام عادلا، ويصلّي في حضور الناس ويطيل السجود والركوع والأذكار الطويلة. هذا الإنسان يضمر في باطنه كلمة للناس هي: «إنني متدين ومحتاط إلى درجة أترك صلاة الجماعة لئلا أبتلي بإمام غير عادل» هذا الإنسان، فضلا عن أنه معجب بنفسه ومُراء، فإنه لا يعرف المسائل الشرعية أيضا، وذلك لأن مرجع تقليد هذا الشخص، قد لا يشترط أكثر من مجرد حسن الظاهر في صحة الإقتداء ولكن عمله هذا ليس من هذا الباب، بل من أجل الرياء أمام الناس، ولأجل الحصول على المكانة والمنزلة في القلوب.
وهكذا سائر أعمالنا، فهي تحت تصرف الشيطان الملعون الذي ينزل في كل قلب كدر ملوث، ويحرق الأعمال الظاهرة والباطنة ويجعلنا من أهل النار عن طريق الأعمال الحسنة.
فصل: في الدعوة إلى الإخلاص
إذاً أيها العزيز، كن دقيقا في أعمالك وحاسب نفسك في كل عمل، وأستنطقها عن الدافع في الأعمال الخيرة، والأمور الشريفة، فما الذي يدفعها إلى السؤال عن مسائل صلاة الليل أو على ترديد الأذكار؟ هل تريد تتفهّم أحكام صلاة الليل وتُعلمها قربة إلى الله، أو تريد أن توحي إلى الناس بأنها من أهل صلاة الليل؟
لماذا تريد أن تخبر الناس بأي أسلوب كان، عن الزيارة للمشاهد المشرفة وحتى عن عدد الزيارات؟
لماذا لا ترضى أن لا يطلع أحد على الصدقات التي تعطيها في الخفاء، وتحاول أن تتحدث عنها ليطّلع عليها الناس؟ إذا كان ذلك لله، وتريد أن يتأسىّ به الناس باعتبار أن «الدال على الخير كفاعله» فإن إظهار حسن، وأشكر الله على هذا الضمير
النقي والقلب الطاهر!.
ولكن ليكن الإنسان حذر في المناظرة والجدال مع النفس، وأن لا ينخدع ب


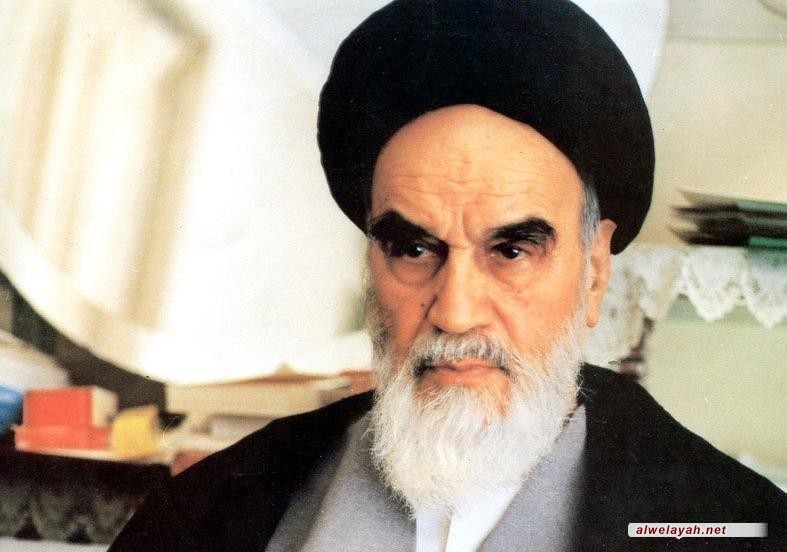




















تعليقات الزوار