 ومع ذلك كلّه فقد يوجد في بعض الكلمات شبهات واهية لا بأس بنا في التعرّض لها وذكر وهنها، وهذه الشبهات إما شبهة في مشروعية الولاية الإلهية من رأس حتى للنبي والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وإما في مشروعية ولاية الفقيه، وإما في إطلاق ولايته.
ومع ذلك كلّه فقد يوجد في بعض الكلمات شبهات واهية لا بأس بنا في التعرّض لها وذكر وهنها، وهذه الشبهات إما شبهة في مشروعية الولاية الإلهية من رأس حتى للنبي والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وإما في مشروعية ولاية الفقيه، وإما في إطلاق ولايته.
أما الأولى: فقد جاء في بعض المسفورات ما معناه: أن بعض تابعي الحكومة الإسلامية يقولون: إن أهمية أحكام الإسلام ومصالحها تدل بالالتزام على ثبوت حكومة ونظام جزائي للشرع، وأرادوا بذلك إثبات المشروعية الدينية للحكومة الإسلامية، وهو كلام مضطرب غير منسجم.
وذلك أن كل حكم وإن فرض كونه في غاية القوة إلاّ أنه لا يمكن أن يكون ناظراً إلى مرحلة إجرائه وامتثاله، فإن امتثال الحكم كعصيانه متفرّع ومتأخر عن ثبوته وتشريعه، ونفس وجود الحكم متأخر عن إرادة تشريعه، فإن كان امتثاله دخيلاً في موضوع الحكم ومن قبيل القيود الدخيلة في ترتب المصلحة على موضوعه يلزم تقدم الشيء على نفسه برتبتين، وهو بديهي الاستحالة، هذا إذا أريد إثبات المشروعية للحكومة من طريق دخل امتثال الأحكام في ترتب المصلحة على موضوعها. وأما إن أريد إثبات مشروعيتها بجعل الشارع تكليفاً شرعياً آخر لغاية إجراء تلك التكاليف التي أنشأها وشرّعها أوّلاً حتى يكون هذا التكليف الثاني موجباً لمشروعية الحكومة الإسلامية فمن الواضح أن نفس هذا التكليف الجديد يحتاج امتثاله إلى تكليف آخر، وهكذا، وهو يوجب التسلسل المحال. فنتيجة الأمر أن مشروعية الحكومة لا تتصور إلاّ بوجه محال.
وصرّح بعد ذلك بأن ولاية النبي وأمير المؤمنين (عَلَيهِما السَّلام) لم تكن بجعل إلهي بل إنّما ثبتت بابتكار الناس من طريق البيعة، وبأدنى تتبع يظهر أن ولاية النبي السياسية لم تكن مأمورية إلهية له، فلم يكن هو قبل بيعة الناس ولي أمر الأمة، بل ولايته حصلت بالبيعة. وهكذا الأمر في أمير المؤمنين (عَليهِ السَّلام)... إلى آخر ما نسج[1].
أقول: إن مشروعية الحكومة الإسلامية لا تتوقف على شيء من هذين الوجهين اللذين كلاهما مستحيل، بل من الممكن أن تكون لولاية النبي أو الإمام المعصوم أو الفقيه مصلحة في كمال الشدة لازمة التحصيل، وكان تحصيل هذه المصلحة بيد إرادة الله تبارك وتعالى وجعله وتشريعه، ولذلك يقوم بتشريع الولاية له ويجعله وليّ أمر الأمة، ويصرّح بقوله تعالى ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾[2] بولايته، وبمثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾[3] بولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم وبمثل الأخبار المتعددة الماضية بولاية الفقيه الواجد للشرائط، ومع ذلك ليس لإبداء أي شبهة في مشروعية ولايتهم سبيل أصلاً.
وبعد قيام هذه الأدلة التي قد عرفت تواتر سندها وقطعية دلالتها بالنسبة للمعصومين (عليهم السَّلام) فلا مجال لتوهم أي دخل لبيعة الناس في أصل ثبوت الولاية لهم (عَليهِم السَّلام)، ولا في وجوب إطاعة الناس عنهم، بل كما مرّت الأدلة كانت البيعة لهم واجبة على الناس، وإذا تحققت البيعة وجب على الناس إطاعتهم بالبيعة أيضاً زائداً على الوجوب الأوّلي الذي كان عليهم قبل البيعة.
وقريب منه أمر ولاية الفقيه، فإنها أيضاً ولاية شرعية وإنما تتوقف فعليتها ـ بعد المفروغية عن كون الفقيه واجداً لجميع الشرائط المعتبرة ـ على قيام الفقيه مقام تصدي إدارة أمر المجتمع الإسلامي كما مرّ تفصيل الكلام فيه، وبذلك تصير ولايته أيضاً فعلية يجب على الأمة الإطاعة عنه والبيعة له.
الشبهة الثانية: ما في بعض المسفورات أيضاً من أن الجمهورية الإسلامية تحت حاكمية ولاية الفقيه ولاية مطلقة كلمة متناقضة نفسها دليل على عدم معقوليتها ومشروعيتها، وذلك أن معنى الولاية ولا سيما المطلقة منها أن الناس كالصغار والمجانين ليس لهم حق رأي ولا مداخلة في أمور الملك أصلاً. ومن الناحية الأخرى أن الجمهورية بمعناها اللغوي والعرفي والسياسي ليست إلاّ حاكمية الناس وتنفي حاكمية أي شخص أو أشخاص عليهم، وعليه فولاية الفقيه معناها نفي الجمهورية والجمهورية نفي ولاية الفقيه وأي أحد فهذه جملة متناقضة، وبالاصطلاح تكون هذه الجملة من قبيل الشرط المخالف لمقتضى العقد، كأن يقال: بعتك هذه الدار بشرط أن لا تملكها.
وعليه، فأخذ آراء الناس على موافقة هذه الحكومة لا اعتبار له شرعياً ولا حقوقياً، بل ساقط عن درجة الاعتبار بالمرّة، والدول والأمم غير الإيرانية يكون سرّ قبولهم لهذه الحكومة ومعاملتهم معها جهلهم بحقيقتها المتناقضة إلى غيره مما نسج[4].
أقول: إن نسج هذه الشبهة متفرع على عدم وقوف هذا الناسج على كيفية الأمر وحقيقته في جمهوريتنا الإسلامية، وذلك أن ولاية الفقيه المتجسّم في الإمام الخميني قدس سره الشريف ـ لم تكن فعليتها منوطة ولا مأخوذة عن آراء أمتنا الإسلامية، بل هي ـ كما اقتضته الأدلة ويقول بها الإمام نفسه أيضاً ـ قد أعطاه الله تعالى إياها، وليس قبول الأمة لها إلاّ بمنـزلة البيعة لمن هو وليّ الأمر لهم، لا دخل له إلاّ دخل قيام الحجة بوجود الناصر المذكور في الخطبة الشقشقية. فحصول الولاية للولي الفقيه لا يحتاج ولا ينبعث عن الآراء الموافقة التي للناس، وهذا المعنى علاوة عن أنه مقتضى الأدلة الشرعية كان مذكوراً بمرّات في كلمات الإمام (رحمه الله) أيضا. إلاّ أنه بعد تسلّم ذلك أراد الإمام رضوان الله عليه أن يبدي الناس آراءهم الموافقة عليه، لأن لا يقول أحد في عصرنا الحاضر أن حكومتكم وولاية الفقيه كانت إجباراً محضاً على الناس وإلا فالناس مخالفون لها، ولذلك قام الإمام (قدّس سرّه) مقام أن عرض كيفية الحكومة ـ أعني ولاية الفقيه ـ على الناس وطلب منهم إبداء رأيهم بالنسبة بها رأياً موافقاً أم مخالفاً، فوافق الناس على هذه الحكومة قريباً من المائة في المائة. وحيث إن جمهور الناس وافقها فقد عبّر عنها بالجمهورية. وبما أنها تحت زعامة الفقيه وولايته فقد اتصفت بأنها تحت حاكمية وولاية الفقيه. وبذلك يظهر عدم أي مناقضة في هذه الجملة الأصيلة المباركة، وأنها ليست من قبيل الشروط المناقضة لمقتضى العقد. وأن أخذ الرأي لموافقتها ليس فيه أي شبهة، كما هو واضح.
الشبهة الثالثة: ما في هذا المسفور أيضاً من أن أحد الوجوه الذي في هذه النسخة المغلوطة لولاية الفقيه الحاكم وهو ينفي مشروعيتها الحقوقية والفقهية في جميع الأزمنة هو الرجوع إلى آراء أكثرية الناس لانتخاب خبراء مجلس خبراء الولاية لتعيين وليّ الأمر. بيانه: أن المفروض أن الناس كلهم في نظام الولاية الفقيه كالصغار والمجانين مولّى عليهم، وحينئذٍ فكيف يتصور أن يكون المولى عليه نفسه يعين وليّ أمره، فإنه إن كان لأحد ـ بحسب الشرع والقانون ـ أن ينتخب ولي أمر لنفسه فهو حينئذٍ بالغ عاقل لا يحتاج إلى ولي أمر فليس مولّى عليه، وبقاعدة التضايف ليس أحد وليّ أمر له. فإذا فرض أنه مولى عليه ومحتاج إلى وليّ الأمر فكيف يسوغ القول بأن له أن ينتخب وليّ أمر لنفسه؟! فوجود ولاية الفقيه المذكورة في القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية باطلة يلزم من وجودها عدمها[5].
أقول: إن هذه الشبهة إنّما كان لها مجال إن كانت الأمة تعيّن خبراء يعطي هؤلاء الخبراء الولاية لمن يعرّفونه وليّ أمر للأمة إذ يؤول إعطاءهم الولاية له إلى إعطاء الأمة له، وهو المحذور المذكور في الشبهة، إلاّ أن الأمر ليس كذلك، بل ـ كما مرّ بيانه ـ إنّ الله تبارك وتعالى أعطى للفقيه الواجد للشرائط اللازمة المتهيئ لإدارة أمر الأمة ولاية أمرهم، وآحاد الأمة أنفسهم لا يقدرون على معرفة ذاك الفقيه سيما إذا كان من بكسوة العلماء والفقهاء متعدّداً، وحينئذٍ يكون قول الخبراء العدول طريقاً معتبراً لمعرفته، فالخبراء الذين ينعقد بهم مجلس الخبراء أقوالهم وشهاداتهم طريق بل طرق معتبرة لتعرّف هذا الفقيه، فهم إنما يعرّفون مَن أعطاه الله هذه الولاية ويشهدون للأمة بأنّ ذاك الذي أعطاه الله ولاية أمر الأمة إنّما هو هذا الفقيه المعيّن، فلا الخبراء يعطونه الولاية مباشرة ولا الناس يعطونها إياه بالواسطة ولا يلزم إيراد وشبهة أصلاً.
وآحاد الأمّة وإن لم يكن لواحد منم من عند نفسه أن يتدخل في أمر من أمور الملك والأمة فإنه مفوض من عند الله تعالى إلى وليّ الأمر، إلاّ أنه يترتب على كل منهم سائر الأحكام، ومنها طريقة البيّنة لهم في إثبات الموضوعات ذوات الأحكام. ومن هذه الموضوعات هو الفقيه ذو الشرائط اللازمة الذي ألقيت عليه إدارة أمر الأمة، فتكون شهادة عدلين فضلاً عن عدول عديدة طريقاً شرعياً قانونياً لإحرازه، فهذا هو ملاك اعتبار شهادة الخبراء على أن ذلك الفقيه هو الذي يتولى إدارة أمر الأمة .
ومنه تعرف أن سرّ اعتبار قول هؤلاء الخبراء شرعاً إنّما هو كونهم خبراء عدولاً، فإذا فرض شهادة آخرين هم أيضاً عدول خبراء على ثبوت الولاية الفعلية لفقيه واجد للشرائط كان قولهم أيضاً طريقاً معتبراً. ومنه يظهر أن جعل انتخاب عدّة من الخبراء في أقطار بلاد الأمة الإسلامية كلّها ـ على النحو المقرّر في القانون ـ إنّما هو لمصلحة رآها ولي أمر الأمة الإمام الخميني (قدّس سرّه) لأن يكون لآحاد الأمة كلهم الاشتراك في تعيين هؤلاء الخبراء، ولأنه رسم عرفي عالمي، وإلا فكل الملاك لاعتبار شهاداتهم إنّما هو أنهم خبراء عدول فهذه الشبهات الثلاثة لا أساس لها أصلاً.
الشبهة الرابعة: ما قد يوجد في بعض الجرائد ممن بحسب الظاهر لا اطلاع علمي له بالموازين الفقيه، وهو إيراد على إطلاق ولاية الفقيه فيقال: إن الولاية المطلقة قابلة للتصور إذا فرضت لله تعالى خالق الأشياء والإنسان، بلحاظ أنه بيده جميع ما للإنسان ولسائر الأشياء. ولعلّه أيضاً ممكن التصور للأنبياء والأئمة المعصومين (عليهم السَّلام) بأن أعطاهم الله تعالى الولاية المطلقة لمصالح يراها. وأما الفقيه فهو ليس إلاّ إنساناً كسائر الأفراد وإن امتاز عليهم بعلمه بمسائل الإسلام، فمجرّد ذلك لا يجوز عند العقل أن يصير سبباً لأن تكون له الولاية المطلقة عل من سواه على نفسه وماله وكل ما يتعلق به. فولاية رئيس المملكة المعبر عنه برئيس الجمهور قابلة للتصور لكون ولايته محدودة في موارد خاصة حسب ما بينته القوانين المختلفة في العالم، وأما الفقيه فبما أنه لا حدّ لولايته ولا قانون يعرّفها فهي أمر غير صحيح لا تخضع له العقول أصلاً. ولذلك كانت ولاية الفقيه بهذا المعنى غير مقبولة عند أكثر الفقهاء وإن مال إليه بعض المتأخرين منهم. فالولاية المطلقة للفقيه عبارة أخرى عن إجبار وإلزام ديني لا يمكن التصديق به.
أقول: إن هذا المقال ناشٍ عن قصور درك قائله، وعدم تصوره للمراد من إطلاق ولاية الفقيه حتى تخيلها بلا حد أصلاً فنقول:
إن الولي الفقيه ليس له أن يخالف حكما إلزامياً شرعياً أصلاً، وحدّ ولايته أن يراعي جميع الأحكام الإسلامية، فلا معنى لأن يتوهم أنه لا حدّ لاختياراته ولا قانون له، بل إنه بعد وجوب رعاية الأحكام الشرعية قد أعطي اختيارات من الشرع الأقدس وفوّض إليه إدارة أمور الأمة وليس محدوداً بالمسير في طريق مخصوص زائداً على ما اجب الله رعايته على كل أحد، فإذا فوّضت إليه إدارة أمور الأمة فهو ليس محصوراً في أن يجعل في رأس البلاد الإسلامي رئيس جمهور مثلاً، ولا أن يجعل مجلس نواب الأمة بنحو مخصوص، ولا أن يجعل للبلاد دستوراً أساسياً، ولا أن يجعل مجلس صيانة ذلك الدستور وصيانة الأحكام الإسلامية، ولا أن يجعل رئيساً لقوة القضاء ولا للقوى المسلحة، ولا أن يجعل مسير جعل القوانين آراء نواب الناس في مجلس خاص، ولا أمثال ذلك من أمور شتى كثيرة متفرقة، بل بعد أن راعى الأحكام الإلهية ففي إدارة البلاد وآحاد الرعية أمر الإدارة إليه، فله أن يقتن القوانين بنفسه أو بجمع خاص ممن يختارهم لهذا الهدف، وله أن يقضي في موارد الخصومات بنفسه أو بجمع خاص ممن يختارهم لهذا الهدف، وله أن يقضي في موارد الخصومات بنفسه أو بخصوص من يجعله لهذا الهدف، وله أن يعين بنفسه من يدير أمر بلدةٍ خاصة أو بلاد أو قرية أو قرى، وله أن يدير أمر الحرب بنفسه أو بأحدٍ أو جمعٍ ممن يختاره. وبالجملة: فكيفية إدارة أمر البلد الإسلامي في جميع الموارد إليه يختار فيها كلّما رآه مصلحة، فليس إليه أمر إدارة أمور كل أحد من أفراد الأمة إليه، بل الناس أيضاً مختارون في قضاء حوائجهم مع رعايتهم للحدود والأحكام الشرعية.
وبعبارة أخرى ـ كما مرّت الإشارة اليها ـ: إن حدّ ولاية وليّ أمر الأمة معصوماً كان أو غيره إنّما هو إرادة أمر المجتمع في بلادهم وسائر أمورهم الاجتماعية، وتعيين ما هو وظيفة البلد الإسلامي في قبال البلدان الأخر. وأما ما يرجع إلى معيشة الناس فالناس أنفسهم ـ مع التأكيد على رعاية الأحكام الشرعية ـ هم المختارون لا حدّ عليهم غير الحدود والالزامات الشرعية. فالقول بأن للوليّ الفقيه ولاية هاهنا أيضاً على أنفس الناس وأموالهم وعلى كل ما يتعلق بهم انحراف عن الصواب وجهلٌ بالمراد من إطلاق الولاية.
وقد مرّ أن الدليل على ثبوت إطلاق الولاية بالمعنى الذي ذكرناه هو إطلاق عنوان الولاية على المؤمنين المذكور في أدلة إثبات الولاية، فقوله تعالى ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾[6] يقتضي ثبوت هذه الولاية المطلقة للنبي الأكرم (صلّى اللهُ علَيهِ وآلهِ وَسلّم). والأخبار الكثيرة القطعية السند والدلالة الواردة ذيل هذه الآية تثبتها ـ بوصف الإطلاق ـ للأئمة المعصومين (عليهم السَّلام). ومثل قول أمير المؤمنين (عَليهِ السَّلام) في الخطبة الشقشقية: «... وما أخذ الله على العلماء أن لا يقرّوا (لا يقاروا ـ النهج) على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم» يثبتها بهذا الوصف للفقهاء الواجدين لجميع الشرائط أيضاً.
وما ذكرناه من الآية والأخبار إنّما هو من باب الأنموذج وإلا ـ فكما عرفت ـ أن الأدلة على إثبات الولاية المطلقة للمعصومين والفقهاء متعددة قد مرّت وربما تأتي إشارة أخرى إليها. وبعد ما ذكرناه ليس في ثبوتها للفقيه الجامع للشرائط أيّة شبهة أصلاً، والحمد لله.
الشبهة الخامسة: أن يقال: إنّ الروايات إنّما دلت على وجوب الرجوع إلى الفقهاء في زمن الغيبة، والمتيقن منها أنّه لا يجوز عدم الاعتناء بهم. وأما اعتبار قول أحد منهم إذا كانوا متعددين فلا فلعل اللازم أن يؤخذ بما رآه جميعهم بعد المشورة في ما بينهم، وربما يدل على وجوب المشورة عليهم قوله تعالى خطاباً للنبي (صلّى اللهُ علَيهِ وآلهِ وَسلّم) ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾[7]. وقوله تعالى حكاية عن أوصاف المؤمنين ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[8] فلا ينبغي الريب في أن تولي أمر الناس من اظهر مصاديق أمور المسلمين، فإذا قال تعالى حكاية عن المؤمنين ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ يستفاد منه وجوب المشورة عليهم في تولّي أمور المسلمين وهو المطلوب.
أقول: إنّ هذه الشبهة بالتقرير المذكور واضحة الضعف جدّاً، فإنه قد مرّت تمامية دلالة الأخبار العديدة المعتبرة السند على ثبوت ولاية الفقيه الواحد الواجد للشرائط بالفعل إذا قام مقام إدارة أمر الأمة وعلى اعتبار الوحدة في ولي الأمر وإن لم يكن معصوماً، ولذلك قلنا بوجوب الرجوع لتعيين هذا الواحد إلى القرعة إذا كان الفقهاء الواجدون للشرائط المتهيئون لإدارة أمر الأمة متعددين، وهذا كله واضح لا مجال للشبهة فيها حتى يقال بوجوب الشورى أخذاً بالمقدار المتيقن.
نعم بعد ذلك ربما ينقدح في الذهن أنه بعد ما صارت الولاية للفقيه فعلية بالقيام مقام إدارة أمر الأمة فليس له أن يختار أمراً من أمورهم بنفسه بل عليه أن يشاور الناس ثم يعزم عليه.
وربما يستدل لوجوبه بآيتين من الكتاب الكريم:
(أحدهما) قوله تعالى خطاباً للنبي الأكرم (صلّى اللهُ علَيهِ وآلهِ وَسلّم) ـ وهو ولي أمر الأمةـ : ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[9].
وجه الاستدلال به: أنه (صلّى اللهُ علَيهِ وآلهِ وَسلّم) وإن كان بنص القرآن الكريم ﴿أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ إلاّ أنه مع ذلك فقد أمره الله تعالى بالمشاورة مع المؤمنين في الأمور التي بيده اختيارها، وبأنه إنّما له أن يعزم فيها بعد ما شاور الناس، ففيه دلالة واضحة على وجوب مشاورة الناس في تلك الأمور ثم العزم فيها بما يراه مصلحة، فهو تكليف عام لكن من كان ولي أمر الأمة وإن كان معصوماً، فيدل على وجوب المشاورة على الفقيه أيضاً إذا صار ولي أمر الأمة.
لكن الحقّ عدم تمامية دلالة الآية على الوجوب، وذلك أن الآية المباركة ـ كما يدل صدرها بوضوح ـ إنّما هي في مقام عدّ نعم الله تعالى على النبي (صلّى اللهُ علَيهِ وآلهِ وَسلّم)، وأن من أوضح هذه النعم أنه ليّن القلب في ملاقاته للأمة ليس غليظه، وأنه إن كان غليظ القلب لانفضوا من حوله، ففي مقام تذكير عظم هذه النعمة المباركة بأمره بالعفو عنهم وبالاستغفار عنهم، وواضح أن العفو إنّما هو عن الأعمال السيئة وعن تضييع مثل حقوق الإنسان، وأن الاستغفار هو طلب أن يغفر الله ذنوب العصاة، ومن البيّن أن العفو عن المضيّع لحقوق الإنسان والاستغفار عن ذنوبه ليس واجباً أبداً، فالأمر بهما من باب إتمام ملاقاتهم بكمال اللين، وهو أمر بأمرٍ راجحٍ مندوب، وهكذا الأمر بالمشاورة معهم أيضاً أمرٌ بإعمال هذه اللين، أمر بأمر راجح مندوب، وملاك جميع هذه الأعمال أن تجتمع الأمة مع ولي الأمر ولا ينفضّوا من حوله، لا أنّ العزم على أمر لا طريق إليه إلاّ بعد أن يشاورهم، بل إن اختيار إدارة أمور الأمة بيد ولي أمرهم. وإذا كان الأمر الصحيح واضحاً عنده لا يرى نفسه محتاجاً إلى مشاورة الغير أصلاً ويعزم على ما يراه مصلحة للناس. نعم إذا لم يكن الأمر واضحاً لديه أو كان عدم المشاورة مع الناس موجباًَ لفساد ـ وإن كان الفساد انفضاض الناس من حوله ـ وجبت عليه المشاورة بعنوانٍ آخر، وإلا فليس في الآية المباركة دلالة على وجوب مشاورة الناس على نبي الإسلام فضلاً عن ولاة أمر الأمة بالكلية.
ومما ربما يدل على إرادة من الندب من الأمر المذكور في الآية المباركة ما رواه العياشي في تفسيره عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب إليَّ أبو جعفر (عَليهِ السَّلام) أن سل فلاناً أن يشير عليّ ويتخير لنفسه، فهو يعلم ما يجوز في بلده وكيف يعامل السلاطين، فان المشورة مباركة، قال الله لنبيه في محكم كتابه ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾، فإن كان ما يقول مما يجوز كنت أصوّب رأيه، وإن كان غير ذلك كنت أضعه على الطريق الواضح إن شاء الله «وشاورهم في الأمر» قال: يعني الاستخارة[10].
ودلالتها على مندوبية المشاورة بعناية: أنه (عَليهِ السَّلام) نصّ أولاً على أنّ المشورة مباركة واستند له بالآية الشريفة، ومن المعلوم أن كون المشورة مباركة أمر عقلائي يستحسنونها لكونها استعانة بعقل الناس واستفادة به، وليست أزيد من حزم في العمل الذي يريد الإنسان أن يفعله، وهو أمر مندوب، ففي الرواية دلالة على أن الغاية المستفادة من الأمر بها في الآية المباركة هذا الندب العقلائي. ويؤيده أنه (عَليهِ السَّلام) فسر المشاورة في آخر كلامه بأنها الاستخارة، ولا ريب في أن الاستخارة في جميع الأمور مستحسنة وليست بواجبة.
(الآية الثالثة) قوله تعالى في سورة الشورى عند ذكر أوصاف المؤمنين المؤمنين ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[11].
وتقريب دلالته: أنه تعالى جعل أمر المؤمنين شورى بينهم، ومعنى كونه شورى بينهم أن يستفاد فيه من رأي كل أحد، قال الفيّومي في المصباح المنير: «شاورته في كذا واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه. فأشار عليّ بكذا: أراني ما عنده فيه من المصلحة فكانت إشارة حسنة... وتشاور القوم واشتوروا، والشورى اسمٌ منه، وأمرهم شورى بينهم مثل قولهم: أمرهم فوضى بينهم، أي لا يستأثر أحد بشيء دون غيره». فكون أمر المؤمنين شورى بينهم لا معنى له إلاّ أن يكون لجميع المؤمنين فيه دخل بإراءة نظره، وأن لا يستأثر رأي أحد دون غيره. وهو عبارة أخرى عن إعمال الاستشارة والأخذ بما تؤدي إليه بعد قياس آراء الناس بعضها إلى بعض واختيار ما يرى أحسن. وبما أن موضوع هذه الفقرة المباركة «أمرهم» وهو شامل لجميع أمورهم فلا محالة من خصائص المؤمنين أن تكون أمورهم بجميعها بمشورة بينهم، ولا معنى له إلاّ إيجاب الاستشارة عليهم في أمورهم كلها، وهو المطلوب فان ما يختاره الولي الفقيه حين توليه لإدارة أمر الأمة لا ريب في أنه من أمور المؤمنين، فلابدّ وأن يكون شورى بين المؤمنين كلّهم حتى لا يخرج عن عموم الآية المباركة.
أقول: لا ينبغي الريب في دلالة الآية المباركة على أن المشورة في الأمور المستحسنة، إلاّ أن الكلام في أنها واجبة أم لها مجرّد استحسان يجتمع مع الندب؟ والتأمل في الآية المباركة بل في الآيات العديدة ـ التي هذه الفقرة ذكرت في بعضها ـ يهدي إلى عدم دلالتها على الإيجاب، فقد قال الله تبارك وتعالى ﴿فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ * وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ﴾[12].
فقد عدّ هذه الصفات العديدة من صفات الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون، وهذه الصفات وإن كان بعضها لازمة الرعاية كاجتناب الكبائر والفواحش وإقامة الصلاة إلاّ أن بعضاً آخر منها ليس كذلك، فمثلاً غفران من آذى مؤمناً وظلمه عدّ من هذه الصفات مع عدم وجوب غفرانه، كما صرّح بجواز القصاص بالمثل في الآيات التالية، وكما أن الإنفاق ممّا رزقه الله ليس دائماً من الواجبات فإن عمدة الصدقات مستحبّة، وحينئذٍ فكون الأمور شورى بينهم لا يدل ذكرها في عداد هذه الصفات على أزيد من كونه مستحباًَ ولا شاهد على وجوبه أصلاً.
فالحق أن مفاد هذه الآيات أيضاً ليس أزيد من حسن المشاورة لا وجوبها، ولا محالة تكون أمور الأمة المفوّضة إلى وليّ الأمر كسائر الأمور ستحسن فيها الاستشارة إذا رآها ذات مصلحة، وكما أن الاستشارة في الأعمال ليست واجبة على الناس فهكذا الأمر في وليّ الأمر. نعم إذا كان هنا أمر لا يعلم المصلحة في فعله وتركه إلاّ بالاستشارة فلا ريب في وجوب الاستشارة فيه حتى يتضح ما هو الأصلح، كما أنه إذا كان ترك المشاورة وعدم الاعتناء بالأعوان والأشخاص موجباً لضعف ولاية الأمر وانفضاض الرعية فهو أيضاً مصلحة أخرى قد توجب المشاورة معهم فالحاصل: أن لا دليل خاصّ على وجوب الاستشارة على خصوص وليّ أمر الأمة.
فالمتحصل من جميع ما مرّ: أنه لا شبهة في أصل مشروعية الولاية على الأمة في الدين الشريف لا بالنسبة لثبوتها للمعصومين (عليهم السَّلام) ولا بالنسبة لثبوتها لغيرهم من الفقهاء أو جمع آخر، كما أنه قد دلّت أدلة معتبرة على ثبوت الولاية على الأمة للفقيه الجامع للشرائط بنصب إلهي، فالفقيه الذي يتهيّأ لإدارة أمر الأمة ولي بالفعل لهم بولاية إلهية، وليس لرأي الناس وانتخابهم دخل في ثبوت الولاية للفقيه، بل إن على الناس أن يروه وليّ أمرهم وأن يطيعوه في جميع ما يكون تحت اختيار ولاة الأمر.
فبعد ذلك فعلينا أن نبحث عن حدود اختيارات الوليّ الفقيه، فنقول:
(يأتي في الدرس اللاحق)
ــــــــــــــــــــ
[1] حكمت وحكومت: ص 165ـ 170.
[2] الأحزاب: 6.
[3] المائدة: 55.
[4] حكمت وحكومت: ص 216 ـ 219.
[5] حكمت وحكومت: ص 219.
[6] الأحزاب: 6.
[7] آل عمران: 159.
[8] الشورى: 38.
[9] آل عمران: 159.
[10] تفسير العياشي: ج1ص204، عنه الوسائل: الباب24 من أبواب أحكام العِشرة ج8ص428 الحديث5.
[11] الشورى: 38.
[12] الشورى: 36ـ41.


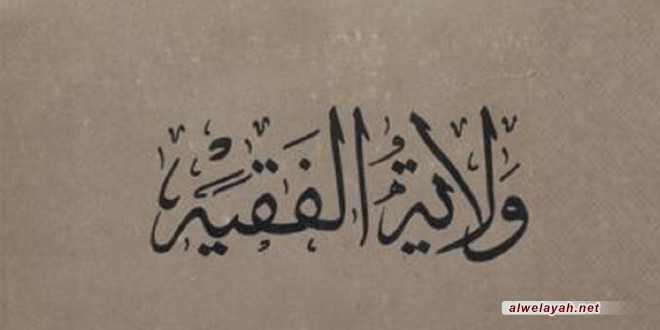




















تعليقات الزوار